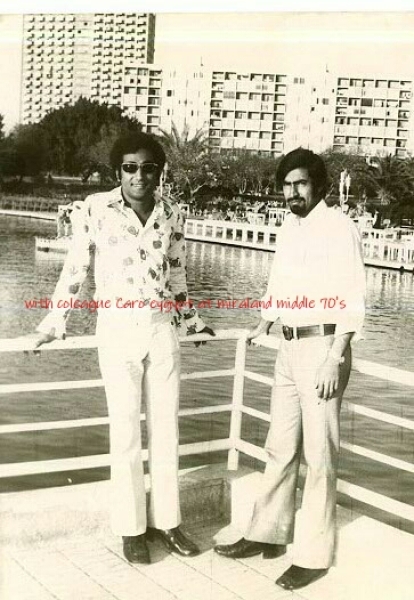-
-

بعض القرارات واحتياجات السوق
لا شك أن التخطيط السليم يؤدي إلى المسار الصحيح، هذا إذا تبعه قرار سليم، والتخطيط السليم لا يتأتى إلا بمجموعة بيانات أو معطيات يتم جمعها من مصادر مختلفة أومن تجارب سابقة، أو عن طريق دراسة ميدانية متأنية، وأهمها استشارة أو استشعار الرأي العام، خاصة إذا كان الهدف من اتخاذ القرار اقتصادياً يمس حياة المواطن اليومية ومعيشته، فالمواطن لايمكن أن يُحَمل فوق طاقته، كما أن لا أحداً يعرف ظروفه المعيشية إلا نفسه، ولا يمكن أن يتحمل المواطن أخطاء غيره،... همش في البداية قبل اتخاذ القرار ثم يطلب منه أن يتحمل نتائجها لسلبية.
التقليد والمحاكاة ليست دائماً ناجحة، ليس ما جرب في مكان ما يصلح في مكان آخر، إذ أن التقليد فيه تبذير للمال...نتبع دون أن ندري نهايتنا، وما ينفق للمحاضرات والندوات في فنادق باهظة التكاليف تمهيداً ومن أجل نقل بعض التجارب من بلدان لا نعرف نتائجها؛ ذلك قرار خاطئ، نحن نعلم بأننا نختلف عنها ثقافياً ومعيشياً، ونختلف في العادات والتقاليد والسلوك الاجتماعي؛ أيضاً ذلك فيه إهدار للمال، لست أدري لماذا لا نعتمد على أنفسنا، نركض لكل صغيرة وكبيرة لاستشارة أجنبي، لماذا لا نعتمد على أنفسنا؟ أليس أهل مكة أدرى بشعابها؟".
بمعنى أوضح إذا كانت الهند قد نجحت في تجربة ما لتنمية اقتصادها، أو ماليزيا مثلاً، كذا سنغافورا، ليس معنى هذا أن نشتري تجاربهم، ونطبقها في بلادنا ونحن نعلم بأن العوامل الأساسية المشتركة بيننا وبينهم لإنجاح هذه التجارب ليست موجودة، ومنها سالفة الذكر؛ كيف لنا أن نتنبأ بنجاح مثل هذه التجارب فقط المسألة إهدار للمال العام؟ ليس هذا فحسب بل طمس لهويتنا ونصبح تابعين للآخرين، وغمط لحق مؤسساتنا التعليمية التي تخرج كل عام أفواجاً من الاختصاصين... بلا شك هؤلاء الخريجون الذين أغدقنا المال على تعليمهم سيذهب هذا المال سدى، والخريجون ستجتذبهم مؤسسات في بلدان أخرى دون أن نستفيد من تعليمهم ونبقى نحن كما نحن معتمدين على الأجانب في كل شيء.... دون الاستفادة من مخرجات التعليم الذي صرفنا عليه المال... أم أن المال الذي يصرف في استجلاب الاستشارات الخارجية غير محسوب؟
هناك الآلاف من الخريجين الذين يتخرجون في جامعاتنا كل عام منهم لا يجد عملاً ومنهم يوزع عشوائياً على مؤسسات القطاع الخاص، دون الاستفادة من التخصصات التي درسوها؛ حتى الذي يستوظف في القطاع العام لا يستفاد من قدراته؛ للأسف دوائر تخطيط المشاريع في القطاع العام وجودها مجرد وكالة لإسناد المناقصات للشركات الاستشارية الأجنبية في البلاد، بالرغم من تكدس المهندسين الأكفاء في أقسامها. حتى في المشاريع البسيطة نرى دراسة جدواها الاقتصادية تعطى للشركات الأجنبية التي لا يستفيد منها كفلاؤها إلا من ذلك المبلغ الرمزي المعلوم الذي يعطى له عند تجديد الإقامة، أو السجل التجاري، وغالباً ما تجد الكفيل لمثل هذه الشركات الاستشارية الأجنبية غير متفرغ أو موظف في القطاع العام...قريب من مصادر المعلومات، أو ممن له نفوذ في تَصَيُد المشاريع.
للأسف الشديد بالرغم من وجود الإمكانات لخلق بيئة عمل علمية لاستيعاب هؤلاء المهندسين؛ مثلاً كإنشاء شركات استشارية فنية للحكومة أو تفعيل دور الاختصاصيين من مهندسين وغيرهم في الدوائر المختصة، لست أدري هل السبب انعدام الثقة؟ أم أن المؤسسات الأكاديمية عندنا بها بعض القصور في التأهيل؟ وإلا ماذا يعني لديك مهندس وتذهب لمهندس أسيوي وافد؟ هذا لا يمكن أن يخفى عن الأعين عندما ترى في مسح الكميات وافد، وفي الإنشاءات الكبرى وافد، وصيانة الطرق والجسور وافد، وفي التمديدات الكهربائية في الضغط العالي وافد، حتى في شركات البترول فالعماني مجرد رقم لإرضاء دوائر التوظيف في الحكومة.
عندما نخطط لتوظيف قوى عاملة محلية يجب أولاً تفعيل القوانين وتطبيقها دون استثناءات، والشركات التي تتردد في توظيف الأيدي المحلية يجب أن تستبعد من القائمة، مهما كانت الحاجة إليها، لأن خيرات هذا البلد أحق به اأبناؤها، ليست عُمان مرعى لكل من هب ودب، وعلينا انتقاء الأعمال التي يجب أن تشغل بمؤهلات دراسية؛ وخصها للعمانيين، إذ رأيت الكثير من الوافدين الذين يعملون في التمديدات الكهربائية سواءً في المحولات - الضغط العالي، أو التمديدات داخل البيوت والمنشئات لا يجيدون القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية؛ فقط من الخبرة تعلموا المهنة، وأيضاً في أعمال الميكانيكا... بينما كلياتنا التقنية يتخرج فيها بالمئات إن لم يكن بالألوف، هذه قسمة غير عادلة "تِلكَ إذاً قسمةٌ ضِيزى".فعلى الجهات المختصة أن تعيد النظر حتى لا يلام المواطن عندما يخرج إلى الشارع ليعبر عن استيائه، لأنه ليس بوسعه أن يُخرج هؤلاء الأجانب المتربعين في الوظائف الفنية بالقطاع الخاص دون مؤهلات، أو بمؤهلات مزيفة. على كل حال؛ أثني على الجهود التي قامت بها وزارة القوى العاملة مؤخراً باتخاذ إجراء ضد 200 مؤسسة لم تلتزم بتوظيف أيدي محلية، هذا هو القرار الصحيح.
ذات يوم كنت في محل حلاقة بقرب منزلي بدارسيت فدخل علينا رجل هندي رافعاً صوته على الحلاقين الذين كانوا منهمكين في عملهم مع الزبائن، فكلما ردوا عليه يزيد من رفع صوته عليهم، فاستغربت أنا ومن معي في المحل، وعندما خرج سألتهم عنه، فقالوا لي "هذا أرباب" يعني رب عملهم، فتعجبت كيف أن يكون لوافد أن يمتلك محلاً تجارياً دون كفيل عماني؟ فسألتهم مرة أخرى فقالوا: "جميع المحلات التجارية بالعمارة ملكه" بينما الكفيل له الاسم التجاري مقابل مبلغ شهري يودع في حسابه، فكانت بالعمارة ستة محلات تجارية: (كوافيرومحل غسيل وكي ملابس، ومحل بيع مواد بناء، ومطعم، ومحل تنظيف وتلميع سيارات). بالإضافة إلى شقق في الطابقين الأخيرين، حينها تذكرت سائق سيارة الأجرة الذي ركبت معه من مبنى البلدية إلى دوار روي، عندما سألته عن سبب استعجاله في السياقة. حيث قال: "مستعجل من أجل اللحاق لسياقة حافلة طلاب المدرسة الهندية، فلما سألته عن مالكها قال "الحافلة يملكها هندي مع عدد سيارات ومنها سيارة الأجرة" التي يسوقها.
فالهنود ترقوا في أعمالهم ويحرصون على تعليم أبنائهم في مدارسهم بالسلطنة، إذ لم يعودوا كالسابق؛ عمال بناء- عمال غير مهرة ـ تركوا هذه الأعمال البسيطة للبنجال، كذا الباكستانيون نراهم يعملون في المعدات الثقيلة أو سواق شاحنات ـ قاطرات، أو في الأعمال الكهربائية كإصلاح المكيفات، والأجهزة المنزلية.
وقد رأينا كيف تزايد عدد العمالة الوافدة في بلادنا بالذات من الهنود والبنجال، خاصة هذه الأخيرة (صفر المؤهلات)، والغريب جلها من صغار السن يعملون خفية في مهن تختلف عن تلك المصرح لهم القيام بها. ولسوء استخدام تصاريح استقدام العمالة الوافدة من قبل بعض المواطنين وغياب الرقابة الميدانية والتوعية كثر العدد، إلى أن وَجِد لهذه العمالة سوقاً ملكاً لمستثمرين من بني جنسهم، سوقاً يعرف محلياً "بالمحلات الشاملة" hypermarket يسوق فيه منتجات بلادهم، بالإضافة إلى المواد الغذائية، والتي هي الأخرى تأتي من بلدانهم.
فعلاً هذه الأسواق نجحت في قتل المحلات الصغيرة التي كان يستعيش منها المواطن، وانتشرت بشكل ملحوظ في الولايات وبمسميات مختلفة، ونصيب تشغيل العماني فيها قد لا يتعدى العشرة بالمائة وفي وظائف متدنية، ومن يزر هذه المحلات من العمانيين سيرى نفسه كأنه نقطة في بحر مقارنة بالجاليات الأجنبية التي سلف ذكرها.
وقد يقول البعض بأن الأموال التي في هذه المحلات استثمار عماني، وأن الأرض المقام عليها هذا المشروع لمواطن أو للحكومة، ولكن يبقى السؤال كم يداً عاملة عمانية تعمل في هذا المشروع؟ وما نصيبهم في الوظائف القيادية؟ وكم ساهمت هذه المحلات في تقليص عدد الباحثين عن عمل؟
بعض الأمور لا تحتاج إلى دراسة خبير، فقط من خلال المعرفة الميدانية للعرض والطلب في السوق، على سبيل المثال إذا كان هناك طلب متزايد من قبل عدد من المواطنين لاستجلاب وافدين لمهن خياطة ملابس نسائية- لمحلات الخياطة، فيجب أن تدرس احتياجات السوق، وأيضاً محلات الحلاقة، يجب مراجعة احتياجات السوق بين فترة وأخرى، هذه الأعمال آنية حسب الموسم، لأنه في الواقع بعض محلات الخياطة؛ مجرد لافتة بينما عامل المحل نجده يعمل سباكاً أو كهربائياً، أو عامل نظافة داخل المنازل، وهذا واقع نلمسه كلما احتجنا لمن يصلح لنا الأعطال الكهربائية في المنزل. ثم منطقياً كيف نصرح لرجل أجنبي أن يعمل خياطاً لملابس نسائية، نسمح له بلمس أجسادهن ولا نوسع نطاق هذه المهنة على الباحثات عن عمل؟
مثل هذه المهن البسيطة التي ذكرتها إضافة إلى ورش الحدادة، والألمنيوم، والميكانيكا- وورش إصلاح السيارات وتنجيد المقاعد وبيع الكماليات (أكسسورات) وأدوات الزينة، وبطاريات السيارات وغيرها من الأعمال الفردية، يجب أن يعطى ترخيص استقدام عمالها فقط لمن يتفرغ لعمله ويشرف عليه شخصياَ، هذا أقل إجراء يمكن أن يتخذ للحد من تزايد العمالة الوافدة، وإلا بقي الوضع كمن يحفر في الرمل.
الزيادة في الرسوم، وتطبيق الضرائب لن يجدي في الحد من تزايد العمالة الوافدة، ربما سينظم طريقة عملها، فبدلاً من أن تكون تجارة مستترة ربما ستكون تجارة مستأجرة، لأن الوافد عندما أتى لممارسة مثل هذه الأعمال هنا عندنا؛ قد وضع في حسبانه هذه الرسوم، والزيادات...اعتاد عليها في بلاده، إذ أن الواقع يفرض عليه أن يكون؛ لكل شيء يقابله شيء،بل سيتمكن من ممارسة العمل في مجال أوسع، وبشكل أفضل، يضيف ما يدفعه للحكومة على سعر المستهلك، وبما أنه يدفع، فسوف يتمتع بامتيازات أفضل، مقارنةً بالخدمات التجارية في بلاده.العمالة الوافدة والمقيمين بشكل عام يتمتعون بخدمات عامة في عمان قد لا تتوفر في بلدانهم إذ أن حالهم حال المواطن لا فرق. وأكثر من يستفيد من هذه الخدمات هم الجاليات الأسيوية الذين أتوا من بلدان كثيرة الضرائب، بها تردي في الخدمات العامة وتلوث بيئي بسبب كثافة السكان.
الهنود والباكستانيون و البنجال وجدوا ملاذاً آمناً للعيش لا يجدونه في بلدانهم، فالمتنزهات، والحدائق العامة، والشواطئ خدماتها مجانية، سعر استهلاك وحدات الكهرباء والماء مدعوم، ووقود السيارات حتى لو سحب عنه الدعم فإنه متوفر بل الأرخص، بدليل الوافد يمتلك احدث السيارات شأنه ذلك شأن المواطن، يذهب بها أينما يشاء في طرق معبدة حديثة دون قيد، هذا إلى جانب وجود دور عبادة ومدارس بمناهج بلاده منتشرة في معظم المحافظات الكبيرة، بل منها بمستوى الكليات بنظام التدريس مقروناً بالعمل. وخير مثال على ذلك المنطقة التي أقطنها (دارسيت) بها سكان تسعون بالمائة منهم أجانب أي أكثر من المواطنين، ومدارس ذات مستوى عالٍ وأكبر محل تجاري بشراكة أجنبية، ودور عبادة لغير المسلمين، هذا إضافة إلى الجامع الذي يكتظ بالمصلين المسلمين منهم، وقس على ذلك بقية المناطق في السلطنة التي تتوزع فيها هذه العمالة بنسب متفاوتة، إذ بلغ إجمالي عدد السكان غير العمانيين حتى الآن أكثر من أربعة وأربعين بالمائة من جملة تعداد السكان.
ماذا ننتظر؟...حتى يفوق هذا العدد أكثر من ذلك؟ ثم نتخبط في الحل؟ لدينا الآن مشكلة الباحثين عن عمل، وحلها ليس بتوجيههم إلى الخدمة العسكرية أو الأمنية الحمد الله رب العالمين بلادنا في أمن وسلام، وزيادة التوظيف في هذا القطاع سيزيد من ارتفاع الإنفاق العام على الرواتب، سواءً أكانت عسكرية أمنية، أم مدنية، بالفعل لدينا الآن مشكلة إنفاق متزايد على أجور الخدمات العامة (كالصحة والتعليم وخدمات البلدية) مع هذا عدد الوافدين في تزايد مستمر، كمن يشرب السم ويشرب الدواء معاُ" (لا حل، الوضع كما هو)، فأنا لست قلقاً على ما يأتي من وراء الشركات الكبيرة التي بها أفواج من العمالة الوافدة، لأن هذه الشركات لها مراكز لإيواء عمالها، وأعمالها معلومة ومحصورة في منطقة معينة، ولكن المشكلة تأتي من المؤسسات الفردية التي بها عمال عُزاب يؤون في إحياء المواطنين بها عائلات، ويدنسونها بأوساخهم، هذا خلاف ما يأتون به من طباع وعادات سيئة، فتجد المساجد رثة، ودورات المياه بها مقززة، والسكك في الأحياء مليئة بالأوساخ وتدفق المياه، هذا ناهيك عن المطاعم والمقاهي التي تسد النفس إذا ما دخلتها. فالزائر الأجنبي أو السائح عندما يأتي إلى منطقة في عمان يعتقد بأن هؤلاء هم السكان، وهذه هي حياتهم، فلا عجب إن يأتي بأكله وشربه معه، فالتوجيه والإرشاد يجب أن يوجه أولاً إلى الوافد الأسيوي قبل العماني، فالعماني لا يرضى أن يوسخ بيته لماذا يحمل ذنب لم يرتكبه؟ وأرجو من البلديات في الأقاليم أن تحذوا حذو بلدية مسقط في شان حملات النظافة تحت شعار "بيئة بلا نفايات".
هناك حلول بسيطة قد لا تحتاج إلى برنامج "تنفيذ" أو اجتماعات في فنادق باهظة التكاليف مصحوبة بضجة إعلامية؛ فقط إنها الجلوس بين رؤساء وحدات الجهاز الإداري المختصة في الدولة والاتفاق على إجراءات معينة وانقضى الأمر. أيعقل أن هناك وزيراً بلا صلاحيات؟ أين شبابنا المتعلم؟ أين حملة الدكتوراة الذين نسمع عن سيرهم الذاتية في إذاعتنا كل يوم؟ ألا يستطيعون حتى تقديم ورَيقَة عمل صغيرة؟ لماذا نُطَول المسألة؟ من مجلس إلى مجلس ونهايتها الحفظ في الأدراج!!
كما أسلفت ركزت الكتابة في هذا الموضوع عن العمالة الوافدة التي تستجلب من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة أو المؤسسات الفردية لإنها تسرح عمالها ويشاركون المواطنين سكنهم في الأحياء التي بها عائلات،...خاصة لما لهذه العمالة من تأثير سلبي على البيئة العمانية، بسبب تكاثرهم، والمتأني في دراسة أحوال هذه العمالة سيرى بأن وجودهم يكلف الدولة كثيراً من المال أكثر مما يتحصل مقابل إقامتهم، يزاحمون المواطنين في كل شيء إذ إن القوانين في السلطنة لا تفرق بين مواطن ووافد أو المقيم فيما يتعلق باستخدام الخدمات والمرافق العامة، لذا نرى أن تَوَفَر المناخ والبيئة المناسبة لاستقرار عملهم في السلطنة ـ سواءً أكان ذلك في أنظمة وقوانين العمل، أم في قوانين وأنظمة الإقامة والانتفاع من المرافق العامة (النقل، الطرق، الاتصالات، الماء، الكهرباء، الحدائق والمتنزهات. تكاليف المعيشة من أكل وشرب وأمن، خدمات بلدية وصحة وتعليم ودور عبادة إلى غير ذلك ـجعل بعضهم ينسى العودة إلى بلاده، كل هذا على حساب صاحب الأرض ـ المواطن. وهذا قد يكون بعضاً ما يفسر تزايد العمالة كل عام لأن بعضهم لا يعود إلى بلاده خاصة الطوائف المسلمة من الهنود والباكستانيين، والبنجال، فمن ينزل سوق مطرح أو روي؛ بالكاد أن يرى تاجراً عمانياً، والعجيب أنهم يبيعون تحفاً هندية على أنها عمانية، لست أدري لماذا؟ فهم في أمكنة حساسة يتردد عليها السواح لماذا لا تُعَمِن هذه المحال التجارية؟
فالحل أولاً وأخيراً كما أرى بيد الحكومة لآن مؤسساتها هي من تعطي تصاريح استقدام العمالة الوافدة، وهي من ترى إذا كان هناك قطاع يستوجب عمالة وافدة أو لا يستوجب، والحكومة من يدرس أوضاع السوق، والحكومة من يسن القوانين، والحكومة من يعرف الذي يتحايل على القانون لآن مسؤولية أمن البلد وسلامته من اختصاصها. إذن لماذا نشير بإصبع الاتهام على المواطن؟ وإذا كنا نعتقد بأن المواطن شريك التنمية فلا بد من إشراكه في اتخاذ القرارات؛ فأنا أقول هذا الكلام ولكن للأسف لا يطبق كما ينبغي مائة بالمائة.
ولكن قبل كل شيء دعوني أروي لكم ما سمعته عن الديمقراطية وعن البيروقراطية وباختصار وهنا أعني بما معناه (حرية الرأي والتعبير أو التشدد، والتمسك بالرأي). سمعت عن إعلامية فنانة لبنانية (من لبنان) سألتها مذيعة بإذاعة (مونتي كارلو) الفرنسية، ربما المذيعة كانت عبير نصراوي في برنامج "بلا قناع" إذا لم تخني الذاكرة، وكانت هذه المقابلة من ضمن السيرة الذاتية عن حياة هذه الإعلامية اللبنانية فقالت ربما على لسان زوجها الفرنسي بأن الفرق بين هاتين الكلمتين في نظر الروس "هو أن البيروقراطية بأنك لا حرية لك في الرأي ولا في التعبير، والديمقراطية لك الحرية أن تقول ما تشاء ولكن يعمل بما لا تشاء" .
فاعتقد هذه الأخيرة هي التي نعمل بها عبر مجالسنا المنتخبة ـ مع أجل الاحترام والتقدير لمن يمثلونا في هذه المجالس ـ هذا إذا جاز لنا "بحرية التعبير وعدم مصادرة الفكر" كما منحنا إياها صاحب الجلالة عبر خطابه. فالمواطن يفترض أن يأخذ برأيه من خلال مجلس البلدي، أو مجلس الشورى، أو استشعار استياءه عبر البث المباشر عبر الإذاعة،... وحديثاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو كل الوسائل الثلاث معاَ، ولكن ليس كل ما يقال يعمل، فالحكومة لديها وسائلها المختلفة وبضغطة زر تعرف كل شيء ما يحتاجه المواطن من خدمات. كما المواطن أيضاً لا يخفى عليه شيء، ولا يحتاج ذلك القدر من التعليم؛ فيكفيه بأن يكون عارفاً بالقراءة والكتابة ويعرف كيف يستشير العم "جوجل" عبر هاتفه المحمول. كل شيء الحمد الله متيسر ومتاح.
ولكن لماذا أقول لا تأخذ استشارة المواطن، ذلك لعدة أسباب، أولاً فيما يتعلق بالعضو المنتخب لتمثيل الولاية، قد تكون أنظمة تسيير الانتخابات الإلكترونية وأنظمة الفرز صحيحة ولكن المشكلة تكمن في مجريات التصويت، هناك من تشترى أصواتهم و(لوبيات)اختيار ودعم العضو المرشح، هذا الكلام صحيح وقد جلست مع كثير من الناس الذين أفصحوا لي عن ذلك جاء منهم هذا كاستياء بعد ما رأوا بأنه بعد أن تم تعيين العضو لم يلتفت لهم بل اقتصر جلوسه مع اللوبي الذي دعمه في التصويت، وأعتقد كذا في المجلس البلدي، حتى إني أكاد أجزم من سيكون الفائز في تمثيل الولاية للفترة القادمة.
والسبب الثاني يتعلق في عملية أخذ القرارات داخل المجلس (الشورى)، كما أسلفت في شرحي عن الديمقراطية والبيروقراطية. أما فيما يتعلق بالمجلس البلدي، أعتقد أنه مجلس دون صلاحيات، ربما لقاءات روتينية تجمع بين الأعضاء، تغلب عليه المجاملات، أرى الحال كما هو في الولاية. بل حتى خدمات النظافة العامة قلت، وآمل ألا تكون هي الأخرى قد تأثرت بأزمة النفط.
إذا أردنا أن ننهض ببلادنا علينا أن نهتم بالتعليم التقني، حتى نواكب متطلبات العصر واحتياجات الاستثمار في المناطق الصناعية، ربما توجيه مخرجات التعليم الأقل من الدبلوم العام إلى التعليم الصناعي، وزيادة رقعة التعليم التقني في المعاهد المتخصصة (معاهد التدريب المهني) أو الكليات، و إدخال أنظمة كليات (البولي تيكنيك) polytechnic المعترف بشهاداتها أوروبياً. بحيث نخلق جيلاً حرفياً في جميع أرجاء البلاد، وألا نصدر التراخيص للأعمال المهنية والأعمال الخدمية التي تحتاج لمؤهلات مهنية أو تجارة التجزئة إلا للعمانيين فقط؛ حتى نوَفِي احتياجات المنشئات الصناعية والخدمية في البلاد.
-
عبد الله السناوي
- شارك

-
عبد الله السناوي
- شارك
-