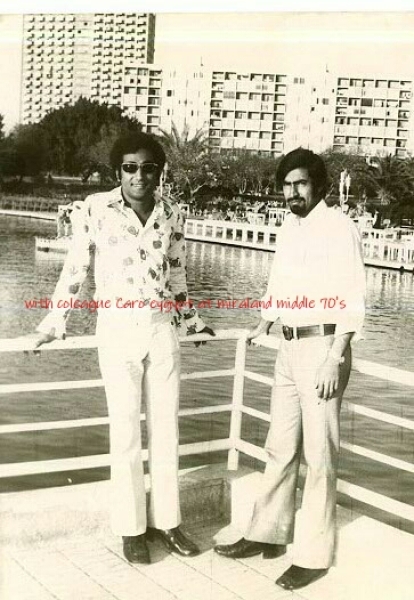-
-

العمالة الوافدة الأسيوية-د
أرى ما يميز مسقط هذا العام (2018م) عن الأعوام السابقة هو الهدوء، فأينما تذهب في مدن مسقط التي اعتدنا أن نرى كثافة سكانية وحركة تجارية؛ صرنا نرى هناك الهدوء، فقد قَلَ ذلك الازدحام على المحلات التجارية، وأعني بالازدحام هنا ازدحام الأجانب؛ العمالة الأسيوية الوافدة، خاصة من البنجاليين والهنود. ربما كثير من هاتين الجنسيتين كانت عمالة سائبة؛ عمالة مُسرحة من قبل كفلائها الذين يعرفون بمصطلح "فري فيزا" أي التأشيرة الحرة، مع العلم لا يوجد هذا المصطلح في دوائر تراخيص استقدام العمالة، هذا المصطلح اصطنع؛ أتت به هذه العمالة بالتفاهم مع بعض العمانيين ضَيِقي الأفق، الذين يأتون بهذه العمالة ويسرحونها في السوق مقابل مبلغ شهري بسيط لا يتجاوز عشرين ريالاً في الشهر عن كل عامل من هذه العمالة.
وللأسف الشديد خلال الأعوام السابقة انتشرت ظاهرة "الفري فيزا" بشكل سريع بدأت في مسقط ومنها انتقلت إلى بقية المدن الكبرى في السلطنة، ومن ثم إلى القرى النائية، وكان بعض المواطنين يستسهلون الأمر، فبدلاً من توظيف الذات نجد بعضهم يستغل التسهيلات التي تجيزها الحكومة ويقومون باستخراج سجل تجاري لكي يستجلبوا هذه العمالة وينشروها في مناطق السلطنة مقابل ذلك المبلغ الزهيد. وللأسف تعرف الحكومة ذلك ولكن لانعدام التنسيق بين دوائرها الخدمية المختلفة ووجود بعض الثغرات في القوانين المنظمة، واستغلال بعض موظفي الحكومة وظائفهم في الجمع بين العمل الرسمي والعمل الخاص، أدى بهذه الظاهرة إلى أن تتنامى بالتدريج إلى أن أدت إلى تكدس العمالة الوافدة في الشوارع وفي أزقة المساكن باحثين عن عمل حتى يجدوا قوت يومهم.
وبسبب رخص هذه الأيدي العاملة؛ أخذ كثير من المواطنين الاستعانة بهم في الأعمال المنزلية وأعمال الصيانة داخل المنازل؛ فَتَعلم الكثير من هذه العمالة الأعمال المهنية بالممارسة، فظهر منهم السباك والكهربائي والنجار والبناء، هذه المهنة الأخيرة تحديداً كان عليها طلب متزايد من قبل المواطنين الذين يقومون ببعض التعديلات في مساكنهم دون خرائط أو الحصول إلى إباحات بناء من قبل السلطات المختصة. لكن السبب يعود لوجود بيروقراطية وعراقيل لا نهاية لها في الدوائر الحكومية والتي لا لازمة لها.
ولكي أكون صادقاً؛ ليس العيب في النظام ولكن في إجراءات التطبيق، وعدم وجود الكادر المدرب على تأدية الخدمة بالشكل الصحيح، فكان التوظيف في السابق لكل من لديه شهادة الثانوية العامة (الدبلوم العام( وشهادة الطباعة على الكمبيوتر، يوظف في العمل دون أن تتوفر لديه أدنى تدريب أو حتى اجتياز دورة تدريبية إدارية معينة في مجال العمل، كان التوظيف فقط لمجرد ملء وظيفة شاغرة... حيث كان هناك شح في موازنات التدريب، ويتم ترقية الموظف ليس على أساس الكفاءة والجودة في العمل بل كان على عدد السنين التي قضاها في الوظيفة،... وما اكتسبه من خبرة من رئيسه حتى لو كانت رديئة، أقول هذا الكلام كوني كنت مسئولاً سابقاً في إحدى المؤسسات الحكومية قبل تخصيصها، ومرت عليَّ حالات لم يكن باستطاعتي معالجتها فعانيت الأمرين، في كثير من هذه الحالات إذ كنت أرغم أن أقبل الموظف هكذا دون وجود برنامج له أو مخطط تدريبي، لأنه أتى من طرف فلان، وعلي أن أتقبل الأمر.
كان يأتي الموظفون وهم ما أسميناهم بموظفي "الترانزيت" موظفي العبور، (موظف الواسطة) يستوظف فقط من أجل الحصول على بعثة دراسية لم ينلها عن طريق وزارة التربية والتعليم (التعليم العالي حالياً). وفي الجانب الآخر عندما يستوظف موظف خريج جامعي مثلاً؛ يأتي وكأن كل شيء مهيء له ومضمون ، يجب معاملته معاملة استثنائية حتى لو تمرد على رئيسه، لا أحد يجرؤ على محاسبته، فظهرت في العمل نوع من الحساسيات بين الموظف المجتهد والذي قد يكون أقل تعليماً وبين الموظف الجامعي المتمرد، فعلى سبيل المثال؛ كان الموظف الجامعي يترفع عن بعض الأعمال البسيطة، يتركها لتؤدى من قبل الموظف الذي هو أقل منه تعليماً حتى لو كان ذلك من اختصاصه وفي نفس القسم، والضحية طبعاً المواطن المراجع الذي يتردد على القسم.
إلى اليوم بالرغم من التحسين الذي طرأ في الدوائر الحكومية إلا أن هناك عيوب وأخطاء فردية ترتكب من قبل بعض الموظفين وتكون بعيدةً عن الرقابة، وهذه العيوب يمكن معالجتها بتدوير العمل بين الموظفين، وتفعيل صناديق الشكاوي والاقتراحات. ليس عيباً أن يشتكى على موظف بل بالعكس هذا في صالحه. ولدي مثالٌ لمثل هذه الأخطاء، ففي الأسبوع الثاني من هذا الشهر يناير 2018م زرت البنك الأهلي بالوطية لكي استرد ملكية أرضي من البنك، وبعد أن استلمت الملكية، ركبت سيارة الأجرة وتوجهت إلى وزارة الإسكان بالخوير لفك الرهن، وعندما دخلت "القاعة الموحدة لإنجاز المعاملات" فرحت، ونسيت تعب المشوار، فقلت في نفسي سأخلص كل شيء في جلسة واحدة. وعندما تقدمت إلى موظف الاستقبال لأخذ رقم انتظار الدور، طلب مني أن يرى سند الملكية، فقال لي: "يجب أن تستخرج رسماً مساحياً جديداً وهذا يتم عن طريق مكتب بريد عمان". فطبعاً لكوني تركت السياقة بسبب ضعف بصري، ركبت سيارة الأجرة مرة ثانية وتوجهت إلى مكتب البريد بروي، وبعد انتظار طويل في مكتب البريد؛ قابلني الموظف المختص بمعاملات وزارة الإسكان وقال لي: "حتى نطلب لك استخراج رسم مساحي جديد لا بد أن يكون لديك رسم مساحي قديم" فلما سألته ليس عندي نسخة ولكن ربما في إبراء، فقال: "اذهب إلى قسم الوثائق في القاعة بوزارة الإسكان المكان الذي أتيت منه وأطلب أن يستخرجوا لك نسخة" فقلت له: لماذا الموظف الذي هناك لم يشر إليّ بما أشرته أنت إلي؟ فرد علي بكل بساطة: "لعله لا يفهم عمله" فضاعت يومي في التنقل بسيارة الأجرة من دارسيت إلى الوطية، ومن هناك إلى الخوير، ومن ثم إلى روي، وأخيراً إلى دارسيت دون أن أنجز شيئاً في وزارة الإسكان، هذه هي "القاعة الموحدة لخدمة العملاء"!! فالعبرة ليست في النظام ولكن فيمن يدير النظام.
فترة التسعينات والثمانينات وحتى بداية عام ألفين، كانت في نظري الشخصي فترة سيئة في انجاز المعاملات، وليس السبب كما يظن بعض الناس أن تحسن الخدمة أتى بسبب إحالة الكثير من الموظفين القدامى إلى التقاعد واستبدالهم بعناصر جديدة؛ هذا لأن الظروف تحسنت بسبب الوسائل الحديثة التي أدخلت في أنظمة الخدمة التي لم تكن موجودة في السابق؛ كالحاسب اللآلي مثلاً، وتوصيف الوظائف من قبل وزارة الخدمة المدنية، وإيجاد درجات مالية عادلة لكل موظف، ثم اختيار الموظف الأنسب لكل عمل، وخلق تنافس بين المتقدمين للوظائف هذه عناصر كلها ساعدت على تحسين جودة العمل عما كان الحال في السابق . التطوير والتغيير أتى مواكباً لمتطلبات العصر، وأصبح الإلمام باللغة الإنجليزية، ومعرفة استخدام الكمبيوتر من أساسيات الوظيفة، كالإلمام بالقراءة والكتابة، وأصبح كل شيء ينجز عن طريق الكمبيوتر واختفى معظم العمل الذي كان ينجز يدوياً، وأخذت الدوائر الحكومية تتسابق في إدخال الوسائل والنظم الحديثة، بل رصدت جوائز لأفضل مؤسسة حكومية تستخدم الحاسب الآلي في انجاز أعمالها.
فبعد أن تشبع القطاع الحكومي، بالكفاءات الوطنية، أصبح من الضروري الالتفات إلى القطاع الخاص باعتباره المحرك الأول للاقتصاد الوطني، لكن كيف يكون للقطاع الخاص دور في تنمية الاقتصاد وبه عمالة وافدة استحوذت على الوظائف فيه من أسفلها إلى أعلاها؟ فأقل ما يمكن أن يعمله القطاع الخاص هو توظيف الكوادر المحلية، خاصة وأنها مدربة ومتعلمة بفضل سياسية التعليم التي انتهجتها الدولة في السنوات الأخيرة، فالوظائف في القطاع الخاص مبنية على الواسطة - بين أقارب الوافدين ـ خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل في مجال التجارة والمقاولات، فكان الوافد يبحث من يكفله بملغ يتفق عليه ثم يأتي بعد ذلك بأقاربه، ويقتصر قبول العمانيين في مؤسسات القطاع الخاص على الوظائف الدنيا كالسياقة، وتخليص المعاملات وبراتب لا يسوى التعب، وفي النهاية يترك العماني العمل ليبحث في مكان آخر، أو يشتغل في سيارة أجرة بعد الدوام.
هناك جهود بذلتها الحكومة لإقناع القطاع الخاص، في توظيف العمانيين، ويسرت لهم السبل، فأقامت الندوات، ووفرت التدريب المجاني لكل عماني يلتحق بالقطاع الخاص، كل ذلك من أجل أن يتقبل أصحاب شركات القطاع الخاص توظيف إخوانهم، ولكن السعي وراء الربح السريع تحت إغراءات هؤلاء الوافدين حالت دون استيعاب القطاع الخاص لمخرجات التعليم خوفاً من الأجور العالية التي قد تدفع للعماني، وبقيت هذه المسألة إلى اليوم رهبة القطاع الخاص في توظيف العماني الكفء في منشآته. وعندما دخل مصطلح "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" في إدارة الأعمال بعمان في العشر سنوات الماضية أسوةً بدول "أسيان" سعت الحكومة إلى تغيير برامجها التمويلية لتشجيع الباحثين عن العمل تحت هذا المصطلح، ووضعت قائمة بالأعمال التي يمكن تمويلها حسب احتياجات السوق، ولكن بقي الوضع مع الوافدين كمن "يقفل الباب ويأتوه من الشباك". فالعِلة في من يكفل هؤلاء الوافدين ويفتح لهم المجال للمنافسة دون مبالاة بالآخرين، فالحكومة ببرامجها التنموية في صوب وهؤلاء المحتالين على القانون في صوب آخر.
أما الفئة الدنيا من هذه العمالة التي تعمل بالتجوال (مِنِيه- مِنِيه) المتسكعة في الأزقة بين المطاعم في انتظار من يأخذها للعمل في بيته؛ هي أكثرها شقاءً عن غيرها خاصة من الجالية البنجالية صفر التعليم. سألت ذات مرة العامل الذي يعمل في منزلي؛ استجلبته كسائق خاص، عن السر وجود كثير من صغار السن من البنجال في البلد، فقال: "البنجالي يبحث عن المال ليس عن العلم ذلك لشدة الفقر في بلاده" ولاحظت خاصة عندنا في إبراء أعمار هؤلاء البنجالة الذين يجوبون الشوارع أعمارهم في العشرينات فيضطر بعضهم إلى تزييف سنه حتى يحصل على عمل في الخليج. وعندما يأتي يتعلم المهنة بالممارسة، يحتك بمن سبقه، ويرافقه في العمل كمعاون حتى لو كان ذلك بدون مقابل إلى أن يتقن صنعه. فتجده يعمل في مهن مختلفة دون أن تكون لديه خلفية دراسية حتى لو من بعيد. وتحضرني هنا قصة بنجالي استجلبه المرحوم والدي في الثمانينات كعامل بناء في مؤسسته، وعندما توقف العمل في المؤسسة وبإلحاح شديد من البنجالي بعدم تسفيره؛ جعله والدي ليعمل في مجال الخياطة (خياطة الملابس النسائية)، فأتقن عمله، وعندما خصصت هذه المهنة من قبل الحكومة للعمانيين، رافق هذا البنجالي صديق له إلى أن تعلم منه حرفة التمديدات الكهربائية (تسليك المنازل) والسباكة... حتى أنه اشتهر بلقب "المهندس"، وهو بالكاد يعرف أن يكتب اسمه بالإنجليزية. فكانت رائدات الأعمال من أخواتنا البدويات يتبعنَهُ حتى البيت بسيارة لاندكروزر ليصلح لهن الكهرباء في محالهن التجارية. بينما أبناؤنا ذوي المؤهلات في هذا التخصص قابعين في البيوت منتظرين الوظيفة عن طريق مكاتب القوى العاملة.
ومن القصص التي أتذكرها في أواخر التسعينات من القرن الماضي، أتتني زميلة في العمل وطلبت مني أن أساعد أخاها الذي تخرج حديثاً من الكلية التقنية في مجال الكهرباء، وكان التوظيف عندنا في ذلك الوقت يتم بالواسطة، من لا يملك واسطة قوية مع "الرئيس" لن ينال أي شيء فكانت شواغر الوظائف محجوزة لأبناء كبار الشخصيات خاصة وظائف "الترانزيت"، التي سبق ذكرها. فصارحتها بالموضوع، واعتذرت لها، ولكني طلبت منها أن تحضر أخاها في اليوم التالي لعلني أساعده بطريقة أو أخرى. فأشرت لأخيها بدلاً من تقصير الدشداشة وإطلاق اللحية والصراع مع أخواته في البيت "هذا حلال وهذا حرام"؛ أن يعمل في الأعمال الحرة، ويبدأ من البيت فأعطيته مائة ريال كقرض لشراء أدوات كهربائية ليبدأ العمل من الحارة التي يسكنها، فصادف ذلك اليوم أن طلب منه إمام المسجد تغيير بعض المصابيح العاطلة في المسجد، فكانت أول انطلاقة له في عمل الحر، وبتوفيق من الله ـ سبحانه وتعالى- استمر في العمل عدة شهور وعندما زاد عليه العمل استعان بوافد هندي مُسَرح ليعاونه، ولم تمض مدة طويلة حتى استحوذ الهندي على العمل...ساحباً البساط من تحته، "فعادت حليمة لعادتها القديمة" كما يقول المثل.
فنجد الأعمال الخدمية كالسباكة، وأعمال الكهرباء بشتى أنواعها، والنجارة وأعمال البناء وتجارة الكماليات في يد الأجنبي، وذلك مغاير لما رخص له؛ حيث نجد في بطاقته المدنية مهنته "خياط" بينما يمارس أعمال الكهرباء، والمواطن يسترخص السعر دون مراعاة احترازات السلامة، فكل ما يعرفه هذا الوافد هو أن يشبك الأسلاك ببعضها فقط، فالسلامة عنده معدومة، فبعدما ينجز عمله يختفي، لا أحد يعرف عنه شيئاً، وليس هناك وجود لرقابة جادة من قبل الحكومة على من يمارسون مثل هذه المهن الخطيرة، والمواطن البسيط لا يدرك المخاطر التي قد تخلفها التوصيلات الكهربائية الرديئة المهم العمل ينجز بأقل تكلفة والسلام. إذن ما فائدة أن نُعلم أبناءنا المهن ولا يعملون فيها؟ فتجد من العمانيين من لديه دبلوم كهرباء يعمل في مهنة سائق سواء أكان في سيارة أجرة أو شركة أو سيارة نقل غاز... هناك خطأ ما في تطبيق القوانين عندنا بلا شك، توجد فئة ممن ليس في مصلحتها تطبيق النظام.
فالمواطن لديه منافس قوي من الأجانب سواءً أكان ذلك في الوظائف الإدارية أو الفنية في شركات القطاع الخاص أم في الحرف المهنية، فهذه الأخيرة مازالت حتى اليوم في أيدي هذه العمالة المنافسة. ومما يؤسف له أن يصل الحال بهؤلاء من مستجلبي العمالة إلى درجة التفاخر بعدد العمال الذين بحوزتهم ، إذ يقاس الثراء عندهم بما يملكونه من هؤلاء العمال )بما لديهم(، وكأنما يملكون قطيعاً من الماشية،)فكلما كان العدد أكبر من العمال، يكون الدخل أكبر). وأذكر هنا قصة من القصص الطريفة؛ فقد جاءتني امرأة بدوية عندما كنت أزاول تجارتي بولاية إبراء، وقد كان هناك دكان شاغر جنب مكتبتي التجارية؛ فسألتني هذه الأخت عم إذا كان ذلك الدكان يود صاحبه تأجيره، وعندما سألتها عن غرضها من الدكان قالت لي: "لهندي" أي لأحد عمالها الذين استجلبتهم، فسكت ولم أرد عليها، ثم عاودت وسألتني عن عدد العمال الوافدين بحوزتي فقلت لها "لا أحد" فاستغربت وقالت لي: "على شهرة اسمك في السوق ما عندك عمال؟" وما كان مني إلا أن سكت ولم أرد عليها، فأنا أبيع كتباً، فكان من المفترض أن تعرف بأن القانون لا يجوز توظيف غير العمانيين في هذه المهنة. كان سكوتي عن الرد لبعض أسئلتها يغيظها ويشد فضولها لمعرفة المزيد عن أسباب نجاحي في السوق، ولم تعلم بأن الخبرة والمعرفة التي اكتسبتها والإصرار على تحقيق الهدف كان الدافع الأساسي في تحقيق النجاح.
مثل هذه الأخت من مُسَرحي العمالة كالذباب الذي ينقل الرمد )عدوى المرض( في العيون، فإنها تأخذ منك الأفكار وتدعي بها المعرفة أمام هؤلاء العمالة دون أن تدري بأنها تقدم لهم أفكاراً تجارية في طبق من ذهب. تحدثت كثيراً في موضوع سابق، في هذا الموقع بعنوان "من متجر صغير 23 يوليو إلى مؤسسة السناوي" وكيف كانت المنافسة تأتي من هؤلاء الوافدين وتحولت التجارة بما عرف بمصطلح "التجارة المستترة" التي تنافس العمانيين الذين هم على رأس أعمالهم.
ومما يجدر الإشارة إليه هنا، أنا لا أتحدث عن بغض لهؤلاء الوافدين الذي قدموا من آسيا ليعملوا في بلادنا؛ بل حاجتنا إليهم دعت الحاجة لذلك وفي مجالات معينة، فالمصلحة مشتركة، فهم أتوا بكفالة من بعضنا، وساهموا بشكل كبير في بناء بلادنا، فهم من شيد المباني، وهم من رصف الشوارع، وهم من زين الحدائق بالأشجار، وهم من استعنا بهم في المزارع، فالمصلحة بيننا مشتركة هؤلاء الأجانب قطعوا آلاف الكيلومترات من أجل كسب العيش، شأنهم شأن العمانيين الذين اغتربوا في شرق أفريقيا، وإلى دول الخليج في مطلع الستينات، ولكن لا بد من التنظيم، "فالأقربون أولى بالمعروف"، هناك مجالات معينة لا بد أن تترك للمواطنين ممارستها حتى يكون هناك توازن في الاقتصاد وأن يجد المواطن رزقاً في بلاده، كفاه اغتراباً في السابق. فالقارب لا يسع لكل حد وكل راعي مسئول عن رعيته.
فترة التسعينات وحتى منتصف عام ألفين بلغت هذه التجارة ذروتها وأصبح الخريج أو المواطن وبمختلف مستوياتهم التعليمية، أصبح من الصعوبة عليهم أن يحصلوا على عمل، لولا تلك النهضة التي حدثت في عام 2011م والتي صاحبت الربيع العربي، والحمد الله لولا تفادي الحكومة الأمر، لتفاقمت الأمور ولكن "رب ضارة نافعة" تلك النهضة ساعدت في تصحيح كثير من الأوضاع التي بررت التغيير في الهيكل التنظيمي في الحكومة.
-
عبد الله السناوي
- شارك

-
عبد الله السناوي
- شارك
-