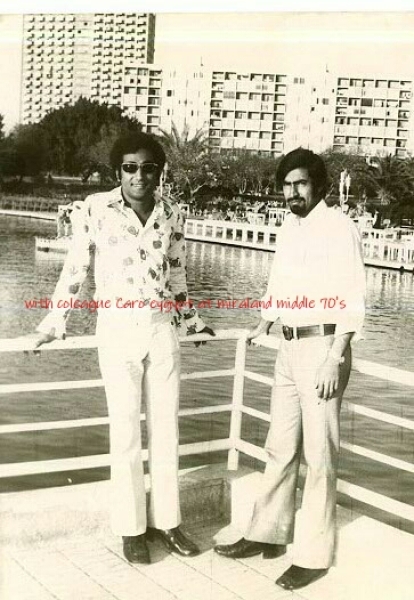-
-


الإعاقة عن تحقيق الأهداف-د
من المعلوم بأن هيكل الإدارة في أي مؤسسة هو هيكل هرمي، تتركز إجراءات أعمالها على القاعدة وليس العكس، بمعنى: يفترض أن يكون عدد العاملين في إدارتها أقل من باقي العاملين، بحيث؛ وفي أي حال من الأحوال لا يتجاوزالعددعن الربع من مجمل عدد العاملين، فالأعمال الكتابية تختصر بتوفير الحاسبات الالكترونية (الكمبيوتر).
ويُصنَفُ الإداريون بأنهمهم من يجلسون على المكاتب غير الحرفيين أو المهنيين ممن يتعاملون مع المعدات والأجهزة. وللأسف ما نراه في مؤسساتنا الخدمية هو العكس، إذ نجد بعض الجهات الحكومية تلجأ إلى تصريف الباحثين عن العمل بإحالتهم إلى الشركات التي تملكها، وتلزم إدارة هذه الشركات بتوظيفهم حتى لو كان ذلك فوق حاجتها، تاركة أمر تخطيط وتوطينهم في الوظائف على إدارة هذه الشركات، كملاذ للتوظيف، وللتقليص من عدد الباحثين عن عمل، وهذه حقيقة قد لا يدركها الجميع، وربما يتم قبول هؤلاء الباحثين عن عمل في الشركات الحكومية؛ مساهمة من هذه الشركات لتخفيف العبء على الحكومة. هذا ما نسمعه بين حين وآخر بأن الشركة الفلانية استوظفت كذا عدد من الموظفين، وفي الحقيقة ومن وجهة نظري إن ما أراه إلا تكدساً وظيفياً.
وينتج عن ذلك التكدس قلة الإنتاج واستهلاك مخصصات الموازنة، وفائض في عدد الموظفين redundant حيث لا توجد لهؤلاء أعمال أو ربما يصعب إعادة تأهيلهم لأعمال آخري، لأسباب عدة منها تكلفة التأهيل والسبب الآخر هو درجة الاستيعاب لدى الأشخاص.
وتكدس الموظفين في المؤسسة الواحدة دون تخطيط مسبق؛ من الأخطاء الشائعة في الشركات العامة (التي تمتلكها الحكومة)، وتلك الأخطاء قد لا يدركها إلا الموظف نفسه، عندما يصبح يتردد في أروقة المكاتب دون عمل محدد له. ونجد أن ذلك العدد الفائض من الموظفين في الشركات العامة لا يسد النقص في عدد الموظفين، والسبب هو عدم وجود الموظف المناسب في الوظيفة المناسبة، أو لوجود ازدواجية في المسؤوليات مما ينتج عنها إتكالية، وقد يقول البعض هذا الكلام غير صحيح، ورب سائل قد يسأل كيف يستوظف موظف دون وجود له وصف وظيفي؟ نظرياً نعم، ذلك صحيح، ولكن عملياً غير ذلك، فعلاً هذا ما يحصل، وقد سمعت من أناس كثيرين ممن استوظفوا وضاقوا مرارة التهميش، حتى من ذوي التخصص حيث ينافسون منافسة غير عادلة من قبل الأجانب، مستنقصين من خبراتهم المتواضعة.
هكذا نرى،تًلَزم الشركات العامة بتوظيف عدد فوق حاجتها، على سبيل المثال إذا كانت الشركة تحتاج إلى مشغلين أو فنيين فإنه يكدس لها ممن يحملون مؤهلات إدارية، ويقع مدير الإدارة بالشركة في ورطة لا يدري كيف يتصرف بهؤلاء، الذين أوكل إليه استقبالهم، بالرغم من الشهادات العالية التي قد يحملونها، لكنهم ليسوا في المجال المطلوب، ويبقى هؤلاء بالشركة بما يعرف redundant عدد زائد، أو كما كنا نطلق عليهم في السابقspectators (متفرجين)لا يستفاد منهم ولا يمكن إعادة تأهيلهم.
فمنهم من لديه شهادة جامعية في مجال آخر بعيد عن حاجة الشركة، أو أن العمل المطلوب دون مستوى الجامعي، أوقد تكون الوظائف المطلوبة وظائف مهنية كالميكانيكا أوالكهرباء، أو تشغيل معدات ثقيلة أو وظائف السياقة وتشغيل الشاحنات أو الحافلات على سبيل المثال في وكالات النقل والشحن والمواني والمطارات، وغيرها من الشركات الخدمية واللوجستية العامة.
والمجتمع العماني مجتمع صغير من ناحية تركيبته السكانية، فتجد معظم الناس أقارب (أخواص ـ باللهجة الدارجة)، معظمهم يعرف بعضهم بعضاً، ويلتقون في كل المناسبات، تجمعهم المجالس الأهلية (السبلة)، يلتقون فيها في الأفراح وفي الأتراح، ويعاود بعضهم بعضاً، سواء أكان ذلك على مستوى الحارة أم القرية أو الولاية. وعندما يلتقون يتحدثون عن أعمالهم وهمومهم في الحياة، كل من يُفَرِج عن نفسه، معظمهم من فخيذة واحدة أو قبيلة واحدة ولا توجد أسرار بين الابن وأبيه ولا بين الأخ وأخيه، فمن السهل أن تعرف كل شيء ما يدور في شركة ما، أو مؤسسة، هذا لأن طبيعة الإنسان العماني سهل العشرة.
هذا، وما أسلفت ذكره قد حصل في الشركة التي عملت بها قبل تقاعدي، وحصل أيضاً كما علمت في شركة النقل الجديدة، وقد كتبت مقالاً مطولاً في هذا الشأن على هذا الموقع، بعنوان "ما قبل الحافلة الحمراء" وأشرت فيه بأن "علينا أن نستفيد من تجاربنا السابقة"، ووسائل النقل من الخدمات اللوجستية الداعمة، التي تعنى بها جميع البرامج التنموية.
أنا من مستخدمي الحافلات الجديدة في تنقلاتي سواءً أكان ذلك داخل ولاية مطرح، أم خارجها إلى مدينة الخوض مثلاً، أو إلى ولاية إبراء. ووجدت معظم السُّواق (السائقين) يتحدثون بنفس النغمة (العمانيين والأجانب) على حد سواء: "ضغط في العمل ... وقطع في الراتب بسبب المخالفات المرورية (الرادارية) التي لا تنتهي، حتى أن هذه الأجهزة أصبحت مصيدة تدر دخلاً دون عناء للجهة المعنية". قد يكون في بعض أقوال هؤلاء السواق شيء من الصحة، ومحقون في بعض الأحيان، خاصة طريق بدبد - إبراء، (في وادي العق)، إذ ليس من المعقول أن يصطاد الرادار كل من يمر على شارع معين، هكذا؟... على الجهة المعنية أن تعيد النظر في برمجة هذا الجهاز، قد يكون المكان الذي وضع فيه الرادار يتطلب سرعة أعلى ـ مثلاً (80) بدلاً من (60) كيلوا مترـ بما يلائم الشارع عملياً. ليس بالضرورة أن نتبع كل شيء دولياً، فلكل بلد مواصفاتها المحلية الخاصة بها؛ كما أعتقد... بما يلائم بيئتها وظروفها.
لقد اختبرت السياقة مراراً على سرعة (60) كيلومتر/ساعة حسب اللافتة الموضوعة على الشارع بين شركة الطرق وقرية الدسر، على شارع بدبد ـ سمائل، فوجئت خلفي طابوراًً من السيارات تستعجلني، أو تنتظرني أن أخرج من الشارع، ظانين أن عطبٌ قد أصاب سيارتي.
ولكي نعود إلى موضوعنا السابق، أذكر قصة عندما ركبت حافلة النقل الوطني (مواصلات) ذات مرة إلى إبراء، أخذ السائق الذي ركبت معه يحدثني بتهكم، عن أوضاع الشركة، بعد أن أنس وجودي، ويتساءل: "كيف لفئة قليلة أن تطعم فئة كثيرة؟ ويشير إلى عمله فيقول: " نحن ممن يأتي بالدخل للشركة، والعدد الأكبر يترنح في الكراسي على براد المكيف"؟ وذكر بأن لديهم قسم كان به عدد ثمانية موظفين إداريين، وأصبح الآن العدد خمسة وأربعون، بينما (السواق) يستقيلون كل يوم فمن وجد فرصة أفضل ترك المكان والتحق بمكان آخر، وكنت أسمع مثل هذا التذمر كثيراً من قبل، وذكرته في المقال السابق: "ما قبل الحافلات الحمراء" وشددت على أهمية أن تكون أولوية الرعاية؛ لمن يأتي بالدخل دون سواه.
في الحقيقة أنا أؤيد التركيز على التعليم التقني أكثر من التعليم الإداري والتجاري، إذ أن هذين المجالين ما هما إلا خدمات لوجستية للخدمات الفنية، كالخدمات الهندسية والصناعية، إذ لا بيع أو شراء دون وجود بضاعة، فالبضاعة لا بد لها من تصنيع، والتصنيع لا بد له من معدات ميكانيكية، أو كهربائية، والكترونية، والمعدات يلزمها فنيين لصيانتها وتشغيلها سواءً أكانت معدات لصناعات تحويلية ، أو معدات وأدوات لخدمات مدنية، في مجال النقل والإنشاءات.
لقد ذكرت في مقالة سابقة (ذكريات 30-د) في هذا الموقع كيف أدى تكدس الموظفين غير المهنيين في الشركة السابقة التي كنت أعمل بها إلى تردي وضع خدماتها بالرغم أنها تمتلك أحدث التكنولوجيا، وعندما سرح 200 موظف دفعة واحدة ممن يمتلكون الخبرات. فقد أحيلوا إلى التقاعد الإجباري، بحجة الخصخصة والتغلب على مشكلة الفائض في عدد الموظفين؛ وجدنا عكس ذلك، بل استوظف ضعف العدد من الخرجين الجدد، واستوظف معهم أجانب ليعينوهم في كتابة التقارير باللغة الإنجليزية، والأعمال الفنية، فقد كان ذلك فقط من أجل إرضاء بعض المعينين، مخالفين بذلك ما سمعناه من أن"التكنولوجيا تقلص العمالة".
ومن الملاحظ في مسقط عن شركة "مواصلات" بأن أغلبية سائقي حافلاتها من الأجانب، بينما تركت السياقة في الخطوط خارج مسقط للعمانيين، الذين يعانون أصلاً من ضغوطات العمل ودوام المناوبة، ومشكلات الطرق.
وظاهرة تكدس الموظفين التي ذكرتها هنا مجرد أمثلة في شركة النقل وشركة الاتصالات، وهذا موجود في معظم الشركات التي تملكها الحكومة، على سبيل المثال الطيران العماني، وغيرها، ذلك من أجل التقليل من عدد الباحثين عن العمل دون مراعاة الجودة، مما سيؤثر بلا شك سلباً على تحقيق الأهداف، ولعل هذا أحد الأسباب التي أدت إلى تعثر بعض الشركات الحكومية عن تحقيق الربح نتيجة ارتفاع الإنفاق الـ overhead expense (النفقات الراسية) التي تُفرَض على الشركات من جراء التوظيف العشوائي.
وعندما يخصخص قطاع معين يجب أن ينظر إليه من زاوية ما يضيفه إلى الاقتصاد وليس فقط من أجل تلبية احتياجات توظيف الباحثين عن العمل فحسب؛ قد تكون هناك قطاعات لا تحتاج إلى عدد كبير من العاملين لتشغيل خدماتها، لديها من التكنولوجيا ما تغنيها عن العمالة اليدوية، كيف لنا أن نطالب الشركات الحكومية تحقيق الربح وهناك عبء على مصروفاتها التشغيلية؟
قد يكون برنامج "تنفيذ" الذي تبنته الحكومة مؤخراً في القطاعات الخمسة من أجل تخفيف الاعتماد على عائدات النفط جيدً؛ خاصة في (قطاع السياحة، وقطاع الصناعات التحولية واللوجستية) حتى لو كان مردود هذه القطاعات قليلاً، (لا يتجاوز15%) أو أكثر فليلاً، من مجمل الدخل، إلا أن هذا بحد ذاته إنجاز إذا طُبق كما ينبغي، و نجاحه بلا شك ستتبعه قطاعات أخرى.
لكن، علينا أن نحترس ونتوخى الحذر، بحيث ألا يؤدي هذا البرنامج إلى زيادة أعداد العمالة الوافدة، لأن بعض الأعمال كالسلسلة؛ حلقاتها متصلة ومرتبطة ببعضها... حلقة تتبعها حلقة أخرى.
فلنضرب مثالاً على ذلك، على سبيل المثال لو أن الحكومة خصخصت إحدى شركاتها، سنجد هذه الأخيرة ستقوم بإعطاء بعض أعمالها لمقاول فرعي subcontract؛ ولشركة قد يملكها عماني اسمياً؛ معظم الأيدي العاملة فيها أجانب...بعذر لا توجد كفاءات وطنية، لكن ذلك ليس هو السبب الحقيقي، بل السبب هو تحقيق الربح السريع بسبب رخص تكلفة تشغيل العمالة الوافدة.
وسنجد أسلوب إعطاء الأعمال لطرف ثالث موجوداً في معظم شركات المقاولات الكبيرة، وفي الشركات الحكومية ذات التخصص الفني المختلفة، خاصة تلك الأعمال التي تحتاج إلى عدد كبير من العمالة، سنجد أعمالها تدار بطريقة subcontract مما تشكل عبئاً توظيفياً على الهيئة المعنية بتوظيف القوى الوطنية، ويضعها بين المطرقة والسندان.
وكما أسلفت في مقالات سابقة قد نبدأ في الرأس وننسى الأطراف؛ (بناء المنتجعات، وبيوت الإيواء) دون الاهتمام بالأطراف، هناك أشياء تبدو صغيرة ونستبسطها، ولكن إذا تمعنا فيها سنجدها ليست كذلك، فالاهتمام بالمرافق العامة شيء أساسي وهي التي يحتاجها الزائر والمقيم على حد سواء، وأولها دورات المياه على الشوارع ومواقف السيارات ومواقف الحافلات، وعلى الشواطئ، وفي كل موقع يتواجد فيه تجمع بشري، وعلى الجهة المعنية بالصحة العامة؛ دور كبير في فيما بعد مراقبة دورات المياه في الأماكن العامة...حتى تلك التي في محطات تعبئة الوقود يجب التأكد من نظافتها، وأن تفتح للعامة، إنه من الصعب على السائح التجوال في المدينة، دون وجود مكان يقضي فيه حاجته، أين سيذهب؟ إلى المساجد مثلاً؟ أم إلى المطاعم التي قد تكون في وقت ما مغلقاً؟
النظافة العامة في الحارات القديمة والسكك والأزقة مهمة جداً أنها الواجهة التي يقصدها السائح الأوروبي، رأيت كثيراً من السياح الأوربيين يحبون التجوال في الأزقة وفي السكك والحارات القديمة لسبر أغوارها. في كثير من السكك خاصة في مطرح (نازي - موجا)، الاسم القديم لتلك الحارة،وقد رأيت المناظر في هذه الحارة قبيحاً جداً؛ الحارة مليئة بالقمامة، وسببها السكان المستأجرون من الجنسيات الأسيوية، ترى صناديق القمامة معبأة إلى الآخر، والأرضية التي تحت الصناديق سوداء من الزيوت، ناهيك عن منظر القطط، وغير ذلك مما يرمى على الأرض حول هذه الصناديق من أثاث ومخلفات بناء، بالرغم من أن البلدية بذلت جهداً كبيراً في تبليط أرضيات الأزقة، ببلاط (الإنتر- لوك)، وتوفير الإنارة لبعض هذه الأزقة. إلا أن الأهمية تكمن في المحافظة على جمال المكان من قبل السكان، وليس فقط بالأنفاق على إزالة الأوساخ.
وللأسف الشديد بالرغم مما توفره الحكومة من امتيازات وتسهيلات للأجانب، وبالذات للأسيويين الذين يشاركون المواطنين في مرافقهم العامة دون تمييز، إلا أننا نجد هؤلاء لا يحترمون هذا الامتياز، ونجدهم في جميع الأمكنة التي يقطنوها قذرة، حتى عندنا في إبراء بعض السكك نجدها طافحة من مياه المجاري جنوب المستشفى القديم، وغير ذلك من مخلفات البناء التي ترمى من قبل العمالة السائبة، (عُمال ـ فري ـ فيزا).
التنبيه والإرشاد يجب أن لا يقتصر باللغة العربية أوعلى العمانيين فقط، فالعماني لا يرضى أن يرى بلاده وسخة، هذه الأوساخ تأتي نتيجة إهمال الوافدين الآسيويين الذين اعتادوا هكذا في بلدانهم...عادة سيئة، أتوا بها مع وزوجاتهم وأصبحت لديهم قناعة رسخت في أذهانهم بأن النظافة من واجبات الحكومة، نظير ما يدفعونه من ضرائب (تاكس)، بينما في عمان كل شيء موفر مجاناً لهم، حالهم حال المواطن، وما يتحصل منهم من رسوم للإقامة وبطاقة العمل لا تساوي عشر ما يتركونه من مخلفات وأوساخ، يكفي ما نراه على المصطحات الخضراء وفي الحدائق العامة، في وقت المساء أيام الجُمع بمحافظة مسقط.
الشيء الآخر الذي أود من الحكومه أن تهتم به هو تحسين شبكة النقل العام، وأن تكون بوتيرة أسرع عن الوضع الحالي، وجعل الحافلات تصل إلى الشوارع الفرعية، وشوارع الخدمات، وأن يتم تحسين مواقف الحافلات سواءً، أكان ذلك من ناحية الموقع أو اتساع مساحتها بما يضمن سلامة الركاب عند الصعود والنزول من الحافلة.
مواقف الحافلات الحالية متعبة وبعيدة على الماشي حتى أن الشخص يفضل أن يستقل اي سيارة أجرة يصادفها بأجر مرتفع عن عناء المسافات التي يقطعها حتى يصل إلى موقف حافلة النقل العام.
توفير دورات المياه وتحسين النقل من أساسيات السياحة، ثم بعد ذلك تأتي نظافة الحدائق العامة، التي تُقلب إلى ساحة مقرفة للقمامة في أوقات المساء، نتيجة إهمال أسر الوافدين الآسيويين التي تلقي بأكياس ومغلفات الأطعمة السريعة بلا مبالاة، حتى أن كثير من الأسر العمانية قل ارتيادها للحدائق بسبب رثاثتها.
للحفاظ على جودة خدمات الحدائق العامة يجب أن تدار بموازنة ذاتية وبشكل تجاري، وباستقلالية في الإدارة، وبشكل تنافسي مع الحدائق الأخرى للحفاظ على جودتها، وجمالها. كذا شواطئ البحر، وأماكن الاسترخاء والتخييم.
هناك شيء آخر يمكن للشباب القيام به أثناء العطل والإجازات أو حتى بعد الدوام الرسمي للعمل، هو مزاولة بيع المرطبات والوجبات الخفيفة على عربات توفرها البلدية لهم، ويمكن تشجيع الشباب أيضاً على ممارسة هواياتهم كالرسم وعزف الموسيقى في الأماكن العامة، و بيع المنتجات الحرفية والألعاب، على الشواطئ وأماكن ارتياد السواح، وفي الحدائق العامة.
تلك الأساليب من شأنها أن تزيد من حركة السياحة الداخلية والخارجية (الأجانب) على حد سواء وهي لا تحتاج إلى كثير من المال، بل في حدود موازنة كل بلدية. وجميع الأشياء التي ذكرتها تكمن في نطاق ومسؤولية وصلاحية بلدية كل منطقة. إنما تحتاج فقط إلى مبادرة وربما تفعيل صلاحية مجالس البلديات في المحافظات ومنحها الاستقلال الذاتي في إدارة مناطقها، قد تكون من الأفكار الصائبة من أجل تطوير المناطق الداخلية.
هذه الأمور البسيطة كما نعلم غير متوفرة الآن، كيف لنا أن نبني سياحة بالقفز إلى الاستنتاج دون الخوض في أدق التفاصيل. السائح لا يريد أن يوضع و(يزت) في سيارة دفع رباعي إلى رمال الشرقية أو ينقل من فندق إلى فندق، إنما أتى لينطلق لزيارة البلد، ويستكشف معالمها ومخالطة اجناسها والتعرف على ثقافتهم، عاداتهم، وتقاليدهم وفلكلور شعبها.
وربما من ألأفضل أن يطلق العنان لكل ولاية أو محافظة الاهتمام بشؤونها في تنمية منطقتها دون الرجوع إلى مسقط، عدا للإشراف والاستشارة فقط، وأن يعطى المجلس البلدي في كل محافظة الصلاحية الكافية في تنمية المحافظة بموازنة ذاتية.
مثل هذه الأمور البسيطة بلا شك داعمة لبرامج السياحة، أهم شيء أن نبتعد بقدر الإمكان عن تكديس العمالة الوافدة، وانطلاقاً من إبراز الهوية العمانية أرى أن جميع أنشطة البيع بالتجزئة بسوق مطرح يجب أن تعمن بالكامل (تشغل من قبل عمانيين)، جميع المنتجات الحرفية والتحف والهدايا والعطور يجب مزاولتها من قبل أيدي عمانية خاصة تجارة التجزئة، أسوة بباقي المهن التي تم تعمينها، أما باقي المشاريع الكبرى الأخرى طبعاً هذه واضحة تحكمها دراسة الجدوى الاقتصادية والتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وهذا ما نُؤمله من برنامج تعزيز القطاعات غير النفطية "تنفيذ".
-
عبد الله السناوي
- شارك

-
عبد الله السناوي
- شارك
-