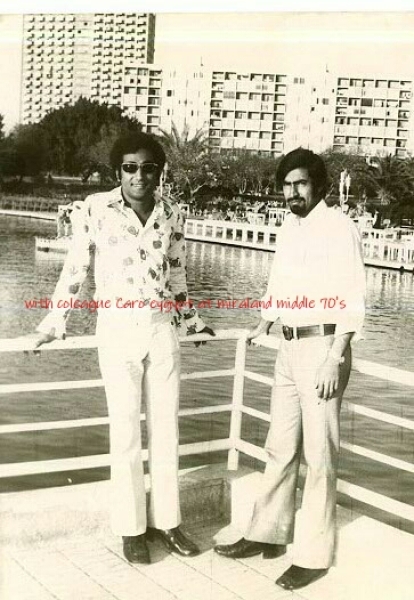-
-


إذا المتحدث مجنوناً فالمستمع عاقلاً
هذا المثل نسمعه دائماً، ويضرب بهذا المثل عندما يشك المستمع في صحة كلام المتحدث، هناك أمور كثيرة تمر على الإنسان مرور الكرام، ومنها ما تستلفت الانتباه، خاصة إذا كان هناك لاشيء ما يشغل الإنسان المتقاعد، أو أنه في إجازة يقضيها في مكان ما هادئ،يغلب على جوها السكون.
ومن الأسئلة التي تراودني بين فترة وأخرى، خاصة عندما أمر على موقف ما سلبي، وتدهشني بعض التصرفات؛ أتساءل في نفسي: لماذا فعل هذا الرجل كذا؟ وتصرف ذاك بكذا؟ لماذا لا ننتظر، ودائما في عجلة من أمرنا؟ هناك آية في سورة الإسراء تذكرتها وبحثت عن تفسيرها:
"وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا" (الإسراء 11) وتفسير الآية، كما ورد في التفسير الميسر: "ويدعو الإنسان أحياناً على نفسه أو ولده أو ماله بالشر، وذلك عند الغضب، مثل ما يدعو بالخير, وهذا من جهل الإنسان وعجلته، ومن رحمة الله به أنه يستجيب له في دعائه بالخير دون الشر، وكان الإنسان بطبعه عجولا".
ولكن السؤال ما زال قائماً؛ لماذا هذا الجهل يعم وطننا العربي فقط، والبلدان المسلمة؛ لقد سمعت ورأيت أيضاً جيراننا العجم يتصرفون مثل هذا التصرف وطباعهم لا تختلف عن طباع العرب، أو ربما يجمعنا إقليم واحد؟ وهو الشرق الأوسط الإقليم ذو الطقس الحار.
مهما يكن هذا ليس مبرراً، فقد يسر الإنسان التكنولوجيا ليكيف بها حاله، هناك أجهزة التكييف في البيت والمكتب والأسواق والسيارة، وهناك أجهزة كمبيوتر (الحاسب الآلي) الذي يتحكم في أمورنا: (في مرور السيارات والمعاملات البنكية والتجارية والمعاملات الشخصية بالمؤسسات الحكومية)، كل شيء تقريباً تحت سيطرة الآلة، ولكن ما زلنا نتجاوزها والبعض منا لا يؤمن بعملها، ستجد الكثير منا يبحث عن(الواسطة) لينجز معاملاته الرسمية أوالتجارية، ولا يلتزم بدوره في طابور الانتظار حتى لو كانت هناك أجهزة آلية تنظم الانتظار، نراه يتخطى الصفوف ويضغط على الموظف أو الموظفة في منضدة الخدمة حتى ترضخ لطلبه وتنجز معاملته، حتى لو كان ذلك على حساب انتظار الآخرين هذا الشخص غير مبالٍ بمن سبقه في الانتظار، المهم استطاع أن يحصل على ما يريد.
للأسف لو كان هذا التصرف يأتي من إنسان جاهل لكان الموضوع أهون، ولكن المصيبة عندما ترى هذا التصرف السلبي يأتي من شاب متعلم، أو نال قسطاً وافياً من التعليم، وبعض من هؤلاء الشباب نراه قبل مغادرة بيته يبدأ التنكيش في هاتفه، للبحث عن صديق قديم يعرفه أو زامله أيام الدراسه ليساعده في إنهاء معاملته غير مؤمن بالأجهزة التكنولوجية التي قد تكون سخرت لمساعدته في تلك المؤسسة التي يقصدها.
المؤسسات الرسمية والتجارية والخدمية في عمان قطعت شوطاً طويلاً في توفير الأجهزة الآلية، لتسهيل الإجراءات على المواطنين، سواء أكان ذلك في الدراسة أو التوظيف أو المرور، أوفي دوائر الهجرة والجوازات، هذا إضافة إلى البنوك والميادين الأخرى من المرافق العامة. وللأسف نرى البعض لا يهمه غيره، أكثر مما تهمه نفسه. عكس ما نراه في بلدان الغرب غير المسلمة.
ويحضرني هنا موقف حدث أمامي عندما كنت جالساً مع بقية المنتظرين، منتظراً دوري لمقابلة الصراف بإحدى البنوك، عندما دخل البنك شخص في الأربعينات من عمره متخطياً الجميع، دون أن يتسلم قسيمة الانتظار من الجهاز، واتجه على الفور إلى منضدة الصراف (الكاشيير) غير مبالٍ بمن سبقه، وعندما رأى في منضدة الصراف شخصاً واحداً بدأ يصرخ ويتذمر متسائلاً: "لماذا لا يوجد شخص آخر؟ هكذا، مكرراً هذه العبارة...أين المدير؟ أين المدير؟..."
ولم يجد أحد من الحضور من يرد عليه، ربما عرفوا أنها حركةٌ منه ليتجاوزهم في الدور، وفعلاً طلب من الموظفة أن تنجز له معاملته على وجه السرعة لأنه مستعجل لديه أغراض في سيارته قد تتلفها حرارة الشمس، كما كان يدعي، فما كان من الموظفة إلا أن أنهت معاملته لتتقي شره.
وبعد لحظات جاءه الرد؛ وُجِد بأن رصيد حسابه "مصفراً" وكاد ذلك الرجل أن يجن فأخذ يصرخ على الموظفة: "لماذا لا يوجد شيء في الحساب؟..." فأجابته الموظفة بأن عليه أقساط شهرين متراكمة للبنك لم يدفعها، فكان كلما يدخل معاشه في الحساب يسرع بسحبه من مكينة الصرف الآلي، قبل أن يخصم البنك القسط. فصرخ في وجه الموظفة واتهمها بالسرقة، وقال لها : "أنتم حرامية...حرامية" نظرت إليه الموظفة باستغراب! وسألته: "أنا حرامية عمي؟" فقال:"نعم، كلكم حرامية" من شدة الغضب، ولم تتمالك الموظفة أعصابها أخذت حقيبتها واستأذنت من مديرة البنك وخرجت تبكي إلى بيت أهلها. وأخذ الناس في البنك يلومونه على تصرفه الأحمق، وعندما توارى عنهم أخذوا يتداولون سيرته بين أخذ ورد، ترك لهم قصة يتسلون بها.
وفي قصة أخرى حكاها لي أحد الأقارب منذ فترة، وقال: عندما كان متجهاً إلى مسقط عبر طريق وادي العق، لاحظ في مرآة السيارة الداخليةـ خلفه سيارة من نوع (لاندكروزر- بك - أب) من النوع الذي يستخدمها البدو، وكان سائقها يضوي له بمصابيح السيارة باستعجال، وشك قريبي هذا بأن يكون هناك خطأ ما قد ارتكبه، ورأى أن يتريث عن الوقوف بحكم خبرته كمدرب (السياقة الوقائية) ولآن الشارع أيضاً ضيق وخطر، به عدد من اللفات...لا يستطيع إفساح له الطريق ، لأن المكان يمنع فيه تجاوز السيارات، وكان هذا الشخص يحثه ويلح عليه بإشارات سيارته أن يخرج عن الطريق، فانتظر قريبي هذا حتى أن وجد الفرصة المناسبة وأركن سيارته في جانب من الطريق ليفسح له المجال.
وبعدما أن اجتازه ذلك الشاب بسيارته، أركنها أمامه وخرج غاضباً يطمطم في كلامه لا يفهم من شدة الغضب، وجاء إلى سيارة قريبي، فأول ما بادره بالكلام كان بعبارة: "هذا الشارع مال أبوك؟" فانعقد لسان قريبي عن الكلام وخرس لم يفك فاه... لم يجد من الكلام ما يرد عليه.فأخذ ذلك الشاب يلوح بيديه متمادياً، مهدداً ومتوعداً... وكان قريبي ملتزماً الصمت. وبعد ما هدأ ذلك الشاب قال له قريبي: "ماذا تريد مني الآن إن كنت تنوي ضربي فأنا أمامك أو خذ رقم سيارتي ونلتقي في مركز الشرطة، أقرب مركز من هنا هو مركز شرطة سمائل... ولكن للأسف يا ابني لم أتوقع أن يصدر منك كلام كهذا من شاب مهندم مثلك، فأنا بمثابة والدك"، وعندما سمع هذا الرد قال الشاب:"لقد عطلتني عن المحاضرة في الجامعة" ودخل سيارته يتأرجح بها شمالاً ويميناً منشغلا في هاتفه، ولم تمض مسافة من ذلك المكان حتى استوقفته دورية الشرطة.
وقصة أخرى حدثت في بريطانيا لشاب عماني كان في بعثة دراسية هناك، قصها لي أحد معارفي عندما زارني في بيتي يقول: "بأن هذا الشاب لديه سيارة، وله جار بريطاني صادقه، وذات يوم جاءت لزوجة البريطاني آلام المخاض، فدق علىصديقه العماني الباب ليسعف زوجته إلى المستشفى، وكان الوقت متأخراً من الليل، وفي الطريق أرتبك العماني من شدة صراخ المرأة، فتجاوز بسيارته إشارة المرور الضوئية.
وبعد فترة استدعي الشاب العماني إلى المحكمة، لمقاضاته على المخالفة المرورية التي ارتكبها. فتعجب الشاب، كيف عرف هؤلاء؟"لا توجد كاميرات مراقبة بتلك الإشارات!!" فلما سأل المحكمة قالوا له بأن صديقه الذي أسعف زوجته هو الذي بلَّغ عنه، فغضب العماني من تصرف صديقه، فعندما واجهه قال البريطاني: "أنت ساعدتني وأنا شاكر لك، ولكن كسرت أنظمة بلادي".هكذا يرقى المستوى الثقافي والحضاري لدى بعض الشعوب، ما فائدة العلم إذا كنا نحن لا نطبقه؟
ومن الأشياء البسيطة التي تلفت انتباه الشخص؛ أتذكر عندما كنت في لندن في السبعينات، أدرس بإحدى الكليات التقنية (Polytechnic college) بشمال لندن، كنت أحرص أن أخرج من البيت المقيم فيه مع العائلة البريطانية مبكراً مشياً على الأقدام إلى الكلية، وفي كل مرة أرى امرأة تمشي خلفي أو أمامي في الطريق بمعطف طويل ملثمة، في نفس الاتجاه إلى الكلية ولم أعرها اهتمامي.
وذات مرة في مقهى الكلية عندما مددت صحني لإحدى العاملات لتملأه بالطعام، ابتسمت إحداهن ابتسامة عريضة، وسألتني: "هل هناك عطل في ساعتك؟" فاستغربت من السؤال، فعرفت فيما بعد بأني تأخرت مرة عن المعتاد للوصول إلى الكية وأنها كانت تضبط موعد خروجها للكلية بخروجي، وأصبحنا رفقاء في الطريق.
ومن الطرائف ذات مرة قرر أحد زملائي العمانيين أن أرافقه لزيارة قريب له يسكن في إحدى المناطق التي يتواجد فيها العرب بلندن،لا أتذكر اسمها، ولكن بعد مشي طويل والتنقل بين محطات القطارات، وصلنا المنطقة، وكنت أنا المرشد، أمشي على خريطة أحملها دائماً في جيبي، ولم يتبق من المشوار عدا مسافة بسيطة من وصولنا المكان المقصود ربما بضع خطوات حتى نصل العمارة؛ فنفذ صبر زميلي من التعب وعندما رأى شرطياً واقفاً في إحدى زوايا الشارع، لم يطق صبراً حتى هرع ليسأله عن المكان فرد عليه الشرطي: "اقرأ اللائحة يا ابني، لديك خريطة". فأضحكني الموقف، وقلت لصديقي ما الذي دعاك حتى هرعت إلى شرطي لتسأله بعد هذا التعب كله؟ فكان صديقي متأثراً من رد الشرطي الذي خيب ظنه، فقال: "أليست الشرطة في خدمة الشعب!؟"...
فالناس في الشرق الأوسط هكذا، يحبون أن يتأكدوا بالسؤال لعدم ثقتهم بالنفس، وأتذكر عندما كانت لدي مكتبة بعد تقاعدي لبيع الكتب أمام عيادة للأسنان بإحدى العمارات بإبراء.كان المراجعون يأتون إلي ليسألوني عن موعد فتح العيادة وإذا كان الدكتور هناك، بينما كل شيء كان واضحاً ومكتوباً على باب العيادة الزجاجي، وحتى إن كانت العيادة مفتوحة، لاحد يكلف نفسه أن يدخل ويسأل الممرضة، حتى إني كنت أتضايق من تلك الأسئلة التي لا تنتهي...
هناك عشرات القصص إن لم تكن مئات مرت علي خلال الأربعين سنة التي قضيتها في الدراسة والعمل والتنقل بين بلدان العالم، ورأيت كيف نتصرف نحن العرب، وكيف نسيء في استخدام الموارد والمرافق العامة، ذلك لعدم استخدامنا للعلم الذي يفترض أن ينير حياتنا، ضاربين بالقوانين والأنظمة بعرض الحائط، بل يعتقد البعض منا ما هذه الأنظمة والقوانين إلا مجرد عراقيل فلذلك كثير منا لا يتقيد بها.
سهلٌ أن نَسأل بدلاً أن نقرأ، وسهلٌ أن يتوسط لنا صديق عن الانتظار، وسهلٌ أن ننتقد قبل أن نتأكد ونتحقق، وسهلٌ أن نلقي باللوم، ونبحث عن شماعة نعلق فيها مبرراتنا...
حتى لو كنا تعلمنا أن نجتنب السلبيات من ديننا لن نؤمن بما تعلمناه أو قراناه:
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ " (الحجرات 12).
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" (الحجرات 6).
وقد عرف أعداؤنا بأننا أمة لا تقرأ ولا نؤمن بما نقرأ، أو ما نتعلمه، فاستغلوا هذه الخاصية فينا وصنعوا لنا الوسيلة التي يمكن من خلالها أن يصلوا إلينا في أي وقت وفي أي مكان يشاءون، ومحاربتنا من بيوتنا وبأبنائنا، بزراعة الفتن وبث الأفكار دون الحاجة لصواريخهم عابرات للقارات، أو احتلال البلدان كما كان يحدث في الماضي... كم من دول قلبت أنظمتها دون تدخل قوى من الخارج، كما كان في العقود السابقة، فقط بزراعة الفتنة والتشكيك في رموزناعبر هذه الوسائل الحديثة التي أصبحت جزء من حياتنا، لا نستغني عنها، وبدلاً أن نوظفها لصالحنا للأحسن للأسف البعض منا أستغلها للتعبير بها عن غضبه غير مبالٍ بالإيجابيات التي تحققت في أرض وطنه، ركز على السلبيات، وقد يكون مدفوعاً ـ والله ـ أعلم، بعناصر مغرضة دون أن يدري، كل ما يهمه هو الظهور على حساب الآخرين.
من لا يعرف الماضي لن يعرف الحاضر، والمحاكاة، والمقارنة ليست دائما المعيار الصحيح، كمن يقارن الفرق بين الإنسان الميسور والمعسور، فالميسور باستطاعته أن يجلب أي شيء بماله بعكس المعسور الذي عليه أن يقتصد ويرتب أولويات احتياجاته حسب ظروفه المادية، لأن الله سبحانه تعالى خلق الدنيا هكذا في تضاد، بين زوجين السالب والموجب. "وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" (الذاريات 49) وأيضاً نختلف في كسب الرزق حيث قال سبحانه تعالى في سورة النحل(الآية 71 ): "وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ" فالناس ليسوا متساوين في الرزق هذه هي سنة الحياة. والاقتصاد كما نعلم يتركب هكذا...
وعندما أتذكر كيف كانت عمان عندما كنت طفلاً, وما أراه من إنجاز خلال ست وأربعين سنة في البنية التحتية، من لا شيء، و بموارد مالية قد تكون بسيطة، أقل بكثير من جيراننا، وتحت قيادة واحدة، متوكلين على الله، معتمدين على الذات متحدين الصعاب؛ هذا بحد ذاته إنجاز عظيم. وعلى جيلنا أن يشكر وأن يكمل مسيرة البناء بهدوء لأنه يملك المعرفة، التي كانت هي هم قائد بلادنا لتوفيرها لأبنائه...من أجل تطوير بلاده قبل رفع البنيان. والحمد الله وصلنا ما صلنا إليه، من علم ومعرفة ورخاء واستقرار اجتماعي وسياسة رشيدة واقتصاد متين. أن سياسة عمان التأني والهدوء والحياد هي التي أكسبتها احترام دول العالم.
وما تبقى هو نقاط على الحروف، الكل يملك مسكناً حديثاً مزوداً بخدماته، الكل يعمل أو يستطيع الحصول على عمل، الخدمات التعليمية والرعاية الصحية متوفرة مجاناً بجميع مستوياتها، الأمن والأمان الحمد الله متوفر، ليس لعمان أعداء، وما تبقى هو التحسين والتطوير، وعلينا معالجته بهدوء علينا نستفيد من العبرالتي حلت بأشقائنا نتيجة الفوضى والتهور من قبل شبابهم، وسوء استخدام للتكنولوجيا التي سخرها لنا الغرب. طالما هناك أنظمة ومسارات لما لا نتبعها لتحقيق مطالبنا، فنحن شعب متعلم، وراسخ، تاريخنا يشهد لنا ذلك؛استعمرنا (عمرنا) بلدان بالفكر والاقتصاد وليس بقوة السلاح وإلى اليوم تدين لنا هذه الدول بالشكر والعرفان. ودعتنا أن نعيد استثمارنا في أراضيها. سجلاتنا بيضاء خالية من أي شوائب لدى المجتمعات الدولية... نسعف الجرحى ونوفق بين الأعداء.
وعندما نخطط لمشروع ما، نضع الأولويات؛ الصحة مثلاً، ثم التعليم ثم الطرق، وبالتدرج تلحق باقي المتطلبات الأخرى، وهذه المشاريع جميعها تمول وفق الإمكانيات التي تأتينا من عائدات النفط. فالدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير ما يمكن توفيره دون الاستدانة من أحد أو بقل قدر ممكن، حتى لا يلقى الدائن ذريعة في لوي ذراعنا وملئ شروطه ليستعمر أفكارنا.
والتخطيط يأتي وفق الحاجة الدائمة والكثافة السكانية، وحسب أولوية الخدمة وأهميتها نحو المجتمع، وتنفيذها يتم وفق الإمكانيات المادية المتاحة. وكما نعلم لكل جهة اختصاص، وشركات الاتصال على سبيل المثال حالها حال شركات النفط تُعطى امتيازاً لتستثمر فيه وإذا كان لدى البعض منا مطالب عليه أن يدق الباب الصحيح، فالمقاطعة ما هي إلا زيادة للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلد من جراء هبوط أسعار النفط. وعندما نقاطع شركة اتصال ما؛ كمن يصب الزيت على النار، هذه الشركات تعطي إيراداً مالياً للدولة شأنها شأن أي قطاع اقتصادي، وربما تأتي مرتبتها الثالثة أو الرابعة من ناحية الدخل للصندوق العام، فمقاطعة استخدام خدماتها كمن يخفض إنتاج براميل النفط بما يعنى التقليص في عدد الموظفين كما حدث في بداية الأزمة لدى الشركات التي تعمل في مجال النقط، لماذا نقطع رزق إخواننا ونخلق بطالة؟ هل ذلك فقط من أجل أن نحقق رغباتنا وفرض سيطرتنا، كما يقول المثل: (العصا أو العصيد)...
لدينا نظام ميسرللمطالبة، لماذا لا نُفَعِّله؟ لماذا دائما نستبق الأحداث؟... على سبيل المثال؛ لدينا رشيد، أو شيخ معين رسمياًمن قبل الحكومة في كل حارة أو حلة، لما لا نمليه بمطالبنا ليقدمها لوالي الولاية حتى يطرحها في المجلس البلدي؟ لما لا نناقش مطالبنا مع مندوبنا عضو مجلس الشورى؟ والذي لديه الصلاحية التي تمكنه من مقابلة الوزير المختص؟ ومن ثم يطرح موضوعنا على مجلس الشورى الذي سيستدعي الوزير ويستجوبه،هذا إذا كان هناك تقصير؟ لماذا نقحم على (التوتير، والواتس ـ أب) أم أنها أسهل للتشهير ونشر الفوضى وإرباك الدولة؟
-
عبد الله السناوي
- شارك

-
عبد الله السناوي
- شارك
-