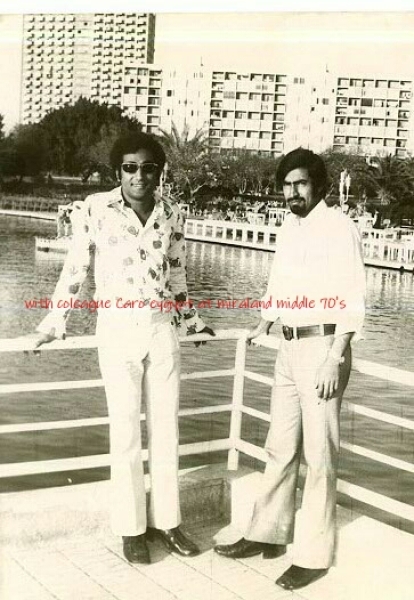-
-


موسم التبسيل في حارة سيح العافية – سفالة إبراء. كلمة تبسيل مشتقة من اسم النخلة التي يأخذ منها البسر بغرض تبسيلة أي طبخه وتجفيفه ثم بيعه مجففاً. عادة رطب نخلة المبسلي لا يأكل، بل يخصص لطعام الماشية، ودواب النقل – الحمير والجمال.
موسم التبسيل عادة ما يأتي في منتصف القيض عند جني البسر من نخلة المبسلي، وهو (تمر من تمور النخل قبل أن يُرطب).
يطبخ بسر المبسلي بغليه على ماء ثم يجفف ويباع بسراً مجففاً، وكانت عمان في الماضي من أبرز الدول الخليجية المصدر ة لهذا المنتج إلى الهند، وبعض الدول المجاورة لها, ربما باكستان.
يتم طبخ بسر المبسلي في مراجل خصصت لها منصة تسمى (تركبة) وتعرف أيضا (باالمنارة) لوجود برج أجوف في المنصة لتصريف الدخان النابع من احتراق سعف النخيل المستخدم لهذا الغرض.
ويظهر في الصورة الوالد علي بن ناصر السناوي، حيث هو أحد المتخصصين في هذه الأعمال. والصورة مهداه عبر وسيلة التواصل الاجتماعي (الواتس –أب) مشكوراً من قبل إبن عمتي الأخ حمد بن سالم بن منصور السناوي..
أحد أضلاع مثلث المعيشة–د ت:
من أساسيات المعيشة، أو متطلباتها الثلاثة: المأكل، والملبس، والمسكن، ثم تأتي الاحتياجات الأخرى كالتعليم من أجل العمل، والنقل من أجل التنقل والاتصال من أجل التواصل، إضافة إلى العبادات، من أجل الشكر" نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ" (القمر 35).
فكلما وفر الإنسان حاجة رغب في اقتناء حاجة أخرى لتحسين وضعه المعيشي. والحمد الله كل هذه المتطلبات متوفرة، بشكل أو بآخر، ويسرت العبادات للمرء أن يقيمها الإنسان في أي مكان يشاء ليشكر سبحانه تعالى على نعمه، طالما الأرض التي يقيم عليها الصلاة طاهرة وغير مغتصبة:
" ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ" (الأنعام 102).
ومن أهم أضلاع المثلث المعيشية من التي ذكرتها، هما ضلعي الأكل والمسكن، ولكن هذا الأخير يتأثر بتقلبات السوق عن غيره بين العرض والطلب في سوق العقار. وما يهمني التحدث عنه الآن في هذا الموضوع هو "الأكل"، وعندما نذكر "الأكل" نعني تلقائياً الغذاء الذي يأتينا من الزراعة.
تَتَبارَى أقلام الكتاب في الكتابة عن هذا الموضوع، وتظهر مقترحات وأفكار، ومنذ سنين طويلة ونحن نسمع، المصطلحات الرنانة (الأمن الغذائي، الناتج المحلي، والدعم الحكومي...)، وأصبحت هذه المصطلحات مفردات يترنم بها كل مسئول لا يجد شيئاً للتحدث عنه في السبلة أو مجالس العزاء... ليظهر ثقافته.فالمتتبع لهذه المفردات يراها ما هي إلا تحصيل حاصل مقتبسة من مقالات كتاب الصحف اليومية.
في شبابي أي منذ ثلاثين سنة كنت أسمع دائماً في المذياع عن اجتماعات وزراء الدول العربية، بشأن مصادر المياه، والأمن الغذائي... وأن جمهورية السودان هي سلة الوطن العربي الغذائية الخ... وفي طفولتي بالذات في سن المدرسة، اعتقدت بأنه لا توجد دولة تزرع وتصدر منتجات النخيل عدا بلدنا عمان.وعندما يأتي موسم الحصاد (الجداد)، والتبسيل، وكَنز التمور في أجربة الخصف (غلف الخوص)، وتنضيدها (تخزينها) أو تصديرها إلى مسقط؛ كنت أرى تلك الأيام كأنها أيام عرس لمزارعي النخيل في عمان...أنهم يحصدون فيها جهدهم وما شقوا من أجله طوال العام، وذلك لأنهم ليس لديهم دخل آخر يقتاتون منه عدا ما يزرعون.
وعندما سافرت إلى دول الخليج في منتصف الستينات ودرست في المنهج الدراسي وتحديداً في مادة الجغرافيا عن التضاريس والمناخ في البلدان العربية، علمت من خلاله بأن أجود التمور في الوطن العربي توجد في البصرة، وهناك دول أخرى تنتج التمور كالملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وبعض البلدان في شمال أفريقيا...وتعجبت!وشكرت ربي على أن عمان ظلت صامدة في فسل النخيل، وإنتاج التمور بطرقها التقليدية البدائية دون عون الماكِينةُ (الآلة)، بالرغم من منافسة هذه الدول العربية الكبرى التي ذكرتها، تزرع وتصدر التمور إلى العالم العربي والإسلامي.
هكذا كان الحال عند المزارع العماني "أن الشدائد تصنع الرجال"، ما زالت أتذكر كيف كنا نجني الخضار من مزارعنا بعوابي "النجادي"، شأننا في ذلك شأن بقية المزارعين في إبراء، نزرع البصل والثوم والفلفل والباذنجان والفجل، معظم ما تحتاجه (مرقة الغداء العماني)، إضافة إلى علف "القت" للأغنام.
وفي مزارعنا في "البلاد" مزارع النخيل (الضواحي)، كنا نزرع ونحصد بالإضافة إلى المحاصيل البستانية من النخيل والمانجو والليمون والموز والفيفاي والسفرجل والزيتون (الجوافة) والعنب، وغيرها من الفاكهة التي كانت يمتلئ بها السوق في ذلك الوقت. وكانت الأسواق في المناطق تضج بالمنتجات الزراعية من شتى المناطق، تجدها أينما ذهبت، وكنا نرى منتجات زراعية أخرى تأتينا على ظهور الجمال من ظفار والباطنة والداخلية ـ جبل الأخضر، بالإضافة إلى الأسماك التي تأتينا مملحة أو مشوية بسبب ظروف النقل من جنوب الشرقية، ولحوم الماشية من البدو من السيوح والجبال، هكذا كنا... " وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ" (الضحى 11) لماذا؟,,,السبب هو "أن الحاجة كانت أم الاختراع" كل فرد في العائلة كان يعمل، وله دورٌ يؤديه، لا مجال للكسل، لا يوجد ما نعرفه في عصرنا الحديث بيوم راحة: الـ (picnic أوweekend ).
أُسرٌ فعلاً كانت منتجة بمعنى الكلمة. يسرك منظر الصباح عند طلوع الشمس وأنت ترى رب الأسرة حاملاً معداته على كتفه نازلاً إلى عمله (المسحاة والقفير) ثم تلحق به الزوجة فيما بعد، وقت الضحى بالتمر والقهوة، مع ما أعدت له لذلك اليوم من فطور. لذا كانت نسبة الطلاق في الماضي قريبة من الصفر، عكس ما نسمعه في وقتنا الحاضر التي قد تصل إلى 22% في بعض المحافظات.
وقد يقول قائل بأن العصر اختلف عن الماضي الذي كان خصباً، بينما الحاضر مَحْلٌ بسبب ندرة الأمطار، والنزف الجائر في المياه، والجواب:هو عكس ذلك لقد قامت الحكومة ببناء السدود لتخزين المياه ومنعها من الهدر، وشرعت القوانين والأنظمة التي تنظم استخدامها، وقدمت الدعم للمزارعين من أسمدة ومعدات وغيرها...كما تخرج الكثير من المهندسين في جامعة السلطان قابوس خلال الخمس والعشرين سنة الماضية، بالإضافة إلى مخرجات الجامعات الأخرى. أين ذهب هؤلاء؟ هل جميعهم استوعبتهم وزارة الزراعة؟ إذن من يدير المزارع الآن؟ عدا وكما نعتقد هي العمالة الأجنبية، للأسف المزارع العماني فرط في مزرعته، ووهبها للعامل الأسيوي ليلعب فيها كما يشاء.
وأتذكر ذات مرة نوه صاحب الجلالة - حفظه ـ الله ورعاه عن هذه الظاهرة في إحدى جولاته السامية، نبه من خطورة الإفراط في إسماد الأرض بالأسمدة الكيماوية، وسوء الاستخدام من قبل العمالة الوافدة، وكلنا نذكر ذلك...ومنذ زمن غير ببعيد، ربما في بداية هذا العام 2016م، كانت هناك صورة من رسالة يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي (الواتس - آب) صادرة من وزيرٍ بدولة شقيقة ينبه فيها وزير الزراعة والثروة السمكة عندنا عن زيادة نسب السماد الكيماوي في منتجات الخضار والفاكهة التي تُصدَّر من عمان إلى بلاده، وأشار الوزير بأنه سيوقف استيراد الخضار والفاكهة من عمان إن لم يتخذ إجراء من قبل الوزارة في عمان لتقليل كميات السماد المستخدم. وذلك في حد ذاته يدل على وجود إهمال في جودة الزراعة عندنا، وغياب الرقابة الحكومية، واتكال المزارعين العمانيين على العمالة الوافدة. كيف لنا أن نعتمد على الريع الذي يأتينا من الزراعة ونحن لدينا هذا الإهمال؟
ولا عجب إن قرأنا في الماضي في صحفنا المحلية عن تفشي ألأمراض السرطانية عندنا؛ لعلها تأتي في المرتبة الثالثة بعد السكري وضغط الدم؟
أسواقنا مليئة بالمنتجات الزراعية المستوردة، كيف لنا أن ندعي بأننا نزرع؟ والخضار والفاكهة تأتينا من الشام والهند وباكستان وجنوب أفريقيا وإيران، ومن دول مجاورة ذات بيئة صحراوية؟ حتى الرمان نستورده من اليمن. هذا خلاف الحمضيات كالليمون التي كانت عمان رائدة في تصديره بألاطنان عبر سفنها الشراعية إلى البلدان التي نستورد منها الآن. هل ذلك يعني أن شح المياه عندنا لا تروي بصلاً، أو حتى شتلة فلفل؟
لاشك أن البعض منا سمع أو قرأ بأن بلادنا كانت في الماضي وحتى عهد الخمسينات مكتفية ذاتياً من المواد الغذائية وكانت تصدر الفائض من التمور والليمون وبعض محاصيل أشجار الجبل الأخضر ومحاصيل أشجار محافظة ظفار. ولا ننسى العمانيون هم من أدخل زراعة القرنفل في شرق أفريقيا في عهد السيد سعيد بن سلطان، بعكس اليوم حتى ماء الشرب نستورده، وعندما أصاب العالم ركود اقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية؛ عمان لم تتأثر، ظلت صامدة لأن شعبها كان يزرع.
في الحلة التي بها مسكني، يوجد محل لبيع الخضار والفاكهة، يعمل فيه بجانب الأسيوي مواطن عماني كبير في السن (في سني تقريباً) أو أكبر مني بقليل، أمي لا يعرف القراءة والكتابة، متقاعدٌ من إحدى الجهات وكنت أشتري من هذا المحل في بداية افتتاحه الخضار، معتقداً بأن المحل ملك لهذا المواطن، وذات مرة سألته إن كان يملك المحل، فقال:"المحل للأسيوي، ليس لي ولا للكفيل، وأنا هنا مجرد صورة، كما ترى أشغل نفسي بالتنظيف، أو التكييس، أين لي أن أملك محلاً كهذا؟" وقادني الفضول أن أسأله إذا كانت المنتجات التي في المحل عمانية، فتبين لي أن كل ما كان يباع مستورد، حتى الليمون الذي يبدو من شكله منتجاً عمانياً كان مستورداً من الهند. فقلت لصديقي هذا: ـ ما شاء الله ـ خضارنا أجنبية، وصاحب المحل أجنبي، وأنت هنا كما قلت مجرد صورة والكفيل موظف في جهة رسمية، وخرجت من المحل متكَدِرَاً مكسور الخاطر.
تذكرت الخبر الذي سمعته منذ أسبوع بإذاعة الـBBC البريطانية الذي يفيد بأن الحكومة الهندية تسعى الآن إلى منح قروض مالية ميسرة للفقراء لتشجيعهم على إقامة مشاريع (الصغيرة والمتناهية الصغر) مثل محلات الخياطة والتجميل ومزارع الخضروات. مما يعني قد نكون نحن السوق المستهدف.
ذلك يجعلنا نتساءل عما إذا كانت الأمطار ـ بحمد الله ـ لا تنقطع، خاصة في الخمس السنوات الأخيرة، والمياه مازالت تجري في بعض الأودية، والدولة لم تبخل في بناء السدود، ولا في دعم المزارعين حسب الصخب الإعلامي الذي نسمعه إذن لماذا لا نرى منتجاتنا الزراعية في الأسواق بارزة كمثيلاتها؟
إلا إذا كان هناك خلل ما؟ وجهودُ لربما غير ظافرة؟ إذن علينا أن نعيد النظر في إدارة المزارع التي تمنح أراضيها للمواطنين، يجب أن تعطى الأولوية لخريجي كليات الزراعة، بدلاً من منحها لشخص أمي يتكل على الأجانب.
يجب أن يتفرغ الممنوح له الأرض بإدارتها بنفسه، وألا تستخدم المزرعة كحديقة للترفيه ولغرض غير زراعي. أما فيما يخص شح المياه علينا بالترشيد، وأن ننتقي المزروعات حسب المواسم، ونركز على الخضار والفاكهة الموسمية، وأن نستخدم وسائل الري الحديثة والبيوت الخضراء، وعلينا أن نشجع على تربية الدواجن والماشية أسوةً بما عمل مع مربي النحل، للاستفادة من أسمدتها ولحومها، وما ينتج عنها. طبعاً مثل هذه الأفكار بالتأكيد ليست بجديدة ولا غائبة عن أذهان المختصين في وزارة الزراعة ولكن فقط من باب:التذكير "فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ" (الأعلى 9).
-
عبد الله السناوي
- شارك

-
عبد الله السناوي
- شارك
-