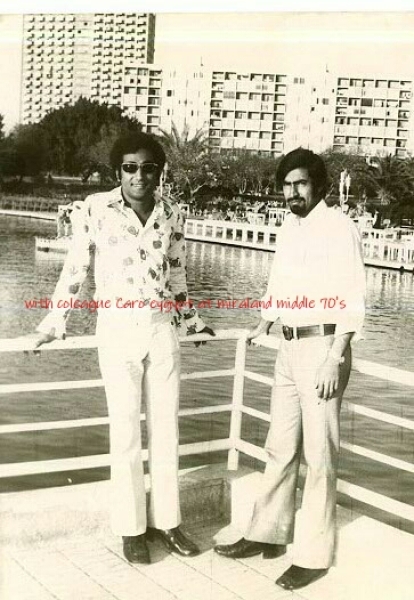-
-


إن الأزمات التي تتعرض لها الدول سواء أكانت اقتصادية أم سياسية، أو اجتماعية (طائفية، مذهبية، معيشية...إلخ) ما هي إلا أزمات عرضية، لها زمن معين وتنتهي، وعلى المرء أن يتقبلها ويكيف نفسه معها، إلى أن تنتهي وتزول. والدول التي تتعرض للأزمات كالإنسان الذي تصيبه وعكة صحية، ولكن سرعان ما تزول إذا ما لزم الهدوء والسكون، واستمع إلى إرشادات الطبيب، وداوم على تناول الدواء.
هناك مرض سببه الإنسان ذاته لنفسه، وهناك مرض سببه ظروف وتقلبات الجو، ليس للإنسان يد حيلة فيه، ولكن على الإنسان أن يصبر وأن يؤمن بقضائه وقدره، ويشكر الله سبحانه تعالي على نعمه.
والأزمات السياسية أو الاقتصادية التي مرت بها بعض الدول كأزمة المفاعل النووي الإيراني مع الغرب، والربيع العربي الذي تعرضت عليه بعض الدول العربية، وتحالف بعض الدول الخليجية وتدخلها في شؤون اليمن، وتحالف الغرب مع بعض الدول العربية ضد سوريا، وقبل هذا كله، الإطاحة بالنظام في العراق، وحرب العراق مع إيران، واجتياح العراق للكويت، ثم الآن الأزمة الاقتصادية، التي يعزى سببها هبوط سعر النفط؛ كل هذه الأزمات السياسية والاقتصادية أزمات مفتعلة، أتت بتحريض من الغرب لتضعف الأنظمة السياسية في الدول العربية، ودول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.إضافة لما سبق عدم التزام الدول الكبرى بالمواثيق الدولية التي تنص على عدم التدخل في شئون الغير، أو لأن تلك المواثيق تطبق فقط على الدول الصغيرة، ولا تسري على الدول الكبرى؛ لأنها هي التي تتحكم في قرارات المنظمات الدولية. لذلك تصبح بعض الأنظمة في الدول العربية ومثيلاتها في الشرق الأوسط ـ سواء أكان نظام الحكم فيها جمهورياً أو ملكياً ـ أذيالاً وتوابع لهذه الدول؛ لا تملك قرار نفسها.
والسبب؛ هو تفرد بعض حكام هذه الدول بالحكم بصرف النظر إن كان نظام الحكم فيها جمهورياً أم ملكياَ، ورأينا هذا في مصر وسوريا وفي العراق، بل بعض الدول العربية التي فيها نظام الحكم جمهوري، فعدلت في دساتيرها لتوريث الحكم حتى يستفرد بالحكم رئيسها؛ وهمش الشعب بطريقة أو بأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر؛ وأقصي عن المشاركة بالرأي أو في إدارة الحكم، وهذا مما يريده الغرب. والمجالس البرلمانية أوالشورى ما هي إلا مجالس شكلية، يؤخذ برأيها أو لا يؤخذ، ليس لها أو بها صلاحية إقالة أو محاسبة مسؤول؛ كالتي نراها في دول الغرب، عندما يخطئ وزير أوتفشل إداراته حينها يطلب منه الاستقالة.
مع هذا فإننا ندعي بأننا مسلمون " وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ " (الشورى 38).
أنظمتنا أنظمة مركبة، لا هي غربية ولا هي إسلامية، حتى في حياتنا العامة هناك ازدواجية، لا نعرف ماذا نريد، نتَعَمد ارتكاب الخطأ ثم نلعن الشيطان. لدينا المال ولا نعرف كيف نستثمره إلا باستشارة الغرب، إتكاليون في معيشتنا نعتمد على الخدم في إدارة بيوتنا وتربية أبنائنا، شعب مستهلك، مما شجع الأجانب على إقامة أسواقهم في بلداننا، ويسرنا لهم القوانين، وامتزجت أطباعنا وثقافتنا بثقافتهم، وأصبحنا نقلدهم في كل شيء؛ في المأكل وفي المشرب وفي الملبس وفي السلوك العام.
تأثرت لغتنا العربية، وأصبحنا نتكلم بلغة مركبة بمصطلحات دخيلة، وبررنا هذا السبب بتداخل الحضارات، وفقدنا الهوية حتى صار بعضنا ينادي بالعولمة، وليس هذا فحسب بل هناك من الأخوات العربيات ممن يسعين بالاختلاط في صفوف الصلاة مع الرجال دون ارتداء الحجاب، بموجب مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، ومنهن من يطالب بإمامة المرأة على الرجال، كالذي نسمعه من بعض المتحررات من الجاليات العربية في سويسرا، (لقاء في برنامج نصف ساعة بإذاعة الـ BBC مع الدكتورة الهام المانع التي القت خطبة الجمعة - الحلقة ربما أذيعت يوم 13 أو 14 من شهر يونيو 2016).
أمام كل هذه المتغيرات، التي أتت بفعل تكنولوجيا العصرالتي قربت المسافات بين الشعوب، مما أتاحت سهولة التنقل والاتصال.
من الطبيعي أن تتأثر الشعوب بعدوى تردي الاقتصاد، بعد أن أصبحت قرية واحدة، ولكن أحسنها من يحسن صيانة بيته في هذه القرية الصغيرة، يشد الحبل عند الضرورة ويرخيه عند اللزوم، دون إفلات.
ومن الطبيعي أن يظهر في الأزمات متحدثون، ومحللون ومنتقدون، وكل يدلي بدلوه، ولكن من الحكمة في إداراة الأزمات أن لا نوسع المشكلة ونعطيها أكثر من حجمها، حتى لا تسبب الذعر للناس، وتصبح المشكلة مشكلتين، مشكلة التحكم وإقناع الناس والتهدئة من روعهم، ومشكلة إيجاد الحل لتخطي الأزمة بهدوء أعصاب.
هذا إذا كانت الدولة بها نظام استشاري مُفَعل، أما الدولة التي غير ذلك وتنفرد بقراراتها ولا تأخذ بمشورة مجالسها المنتخبة، نجدها لا تلجأ لهذه المجالس إلا عندما تتفاقم عندها المشكلة وتود تبليغ رسالة للعامة من خلال المجالس تفادياً للشوشرةوللمساهمة في تخطي الأزمة، أو لكسب ثقتهم وولائهم.
تماما كالفرد في العائلة طالما عنده المال والله سبحانه تعالى رزقه الصحة، تجده بعيداً، مقاطعاً لعائلته، وعندما يقع في مشكلة يتقرب إليها، ويتودد لها حتى يقفوا معه ويجعل من مشكلته مشكلة عامة أي يشركهم في دفع ثمن أخطائه.
كثيراً ما اسمع بأن بلدنا مرت بعدة أزمات اقتصادية في السابق، ولكن بفضل الله تخطتها؛ نقول هذا صحيح، ولكن يجب أن لا نقارن بين الأزمنة، الناس في الأزمنة الماضية ليسوا كالناس في هذا الزمان، كان آباؤنا وأجدادنا يعتمدون على أنفسهم في معيشتهم، شعب يعمل وينتج ومكتفياً ذاتياً، ولديه ولاء لوطنه، لا يعمل براتب ومتكل على الخدم ومثقل بديون بنكية.
نحن القدامى نتفهم الوضع، ونقدر ما أنجز، ونقف ضد كل من نراه لا يشكر على النعمة التي نحن فيها، لأننا نقارن صعوبة الماضي براحة الحاضر. أماالبعض بمن ولد في عصر النهضة، بعد عام السبعين من القرن الماضي (جيل النهضة) وجد كل شيء موفراً ومسخراً له، مع هذا تجده يطالب بالمزيد لأنه كما يدعي من حقه كمواطن، ولا يرضى التنازل، بالرغم مما ناله من تعليم مجاني، ورعاية صحية مجانية، وأمن، وعمل مريح بدوام موقوت، وإجازة راحة في نهاية كل عام، ومسكن حديث، ووسائل اتصال ونقل حديثة... يسافر أينما يشاء إلى أقصى بقاع العالم في سويعات قليلة، ولم يفكر في يوم من الأيام، بأنه سيحتاج إلى قرشه الأبيض ليومه الأسود.
ولما تأتي لبلاده أزمة اقتصادية، متأثرة بأسعار النفط العالمية، يبدأ بالتولول والتذمر، وتصيد الأخطاء لينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يبادر لو بمساهمة بسيطة في التقليل من استنزاف الموارد التي سًخرت له بدعم حكومي كالطاقة، والمياه، وخدمات النظافة، والمرافق العامة... لطالما سعت الدولة إلى إيجاد موارد بديلة غير نفطية من أجل تعزيز الدخل القومي ولكن كانت الاستجابة من المواطن وما زالت ضعيفة لا ترقى إلى المستوى المطلوب في التحمل والتفرغ لإدارة القطاع الخاص، حتى يتم الاستغناء عن الأجنبي بقدر الإمكان.
بالرغم من وجود صناديق الدعم المالي التي أنشأتها الدولة لدعم الشباب حتى يتحمل مسؤولية هذا القطاع على ضوء الخطة الإستراتيجية التي أقرت (20/80)، فبدلاً أن تنعكس الآية لتتحمل الحكومة العبء الأصغر والقطاع الخاص العبء الأكبر في التنمية، ظل الوضع كما هو، بل زاد التوظيف الإدراي في الحكومة على أثر تظاهرات 2011م ولم نر لهذا التوظيف مساهمة تنموية عدا كونه إنفاق زائد من المال العام، توظيف لا إيرادي (ريعي)، حيث كل التوظيف ذهب إلى قطاع الشرطة والدفاع، دون أن يستثمر في مشاريع تنموية، ذات عائد أو مردود عالي في الاقتصاد الوطني.
إذن، كما راينا المشكلة عامة لا تُحصر في جهة معينة، النفط يشكل ثمانين في المائة من دخلنا القومي، وتذبذب أسعاره تحكمه أوضاع سياسية في العالم، وفي الجانب الآخر لا نجد من أبناء الوطن ممن سيشمر ساعديه، وينفض الغبار عن نفسه حتى ينهض بالقطاع الخاص، وإزاحة الأجنبي من هذا القطاع. إذن ما الحل؟ هل نبقى مكتوفي الأيدي؟ متقوقعين هكذا؟ منتظرين الرحمة من الأجنبي؟ من داخل البلاد أو خارجها؟
بالرغم أن الحكومة سعت جاهدة في الماضي ومازالت تيسر الوسائل والقوانين والأنظمة للمواطن، ولكن للأسف أساء بعض المواطنين التصرف، وكان من يحصل منهم على امتياز أو قرض حكومي؛ يركض به للأجنبي حتى يعطيه نصيبه من الفتات؛ من ريع مجهوده،أولئك غير مدركين بأن ما يقومون به هو إساءة إلى اقتصاد البلد؛ عندما تذهب الأموال إلى الخارج من جراء التحويلات الأجنبية.
تلك المحاضرة التي قُدمت في مجلس الشورى في الأسابيع الماضية من هذا الشهر (يونيو 2016)، لم تعط حلولاً بقدر ما كانت تشخيصاً للمشكلة. أنا كمواطن عادي لا يهمني التشخيص بقدر ما يهمني العلاج، ما فائدة تشخيص دون علاج؟ إلا لزيادة الأرق، ومبعث للقلق، ورفع لضغط الدم. وقد رأينا لب المشكلة تكمن أغلبها في الإنفاق على الرواتب، وهذا قد يكون سببها نتيجة التوظيف الذي تم في الماضي نتيجة تظاهرات 2011م غير التنموي, والترقيات أو ربما (المحسوبية)، التي خصت بها جهات دون أخرى-والله أعلم.
ولكن هذه المشكلة (مشكلة التوظيف) محلولة لماذا لا نصدر عمالة مدربة وكفاءات الى دول الجوار كما تفعل بعض الدول، لتنافس العمالة الوافدة هناك؟ إذا كنا فعلاً لا نجد لهم عمل في بلادهم؟ ونحصل على تحويلات مالية كما تفعل العمالة الأسيوية عندما تصدر الأموال إلى بلدانها؟، لا أرى هناك مشكلة، طالما الشخص يملك الشهادة والخبرة. إذ يمكنه أن يعمل في أي مكان يشاء، ليس بالضرورة في بلده، طالما يملك الصحة والنشاط؛ بل بالعكس ستستفيد منه بلاده بشكل أكبر عندما يعود إليها و معه خبرات جديدة.
ويمكن توجيه البعض في شركاتاستثمارية تملكها أو تؤسسها الدولة، شركات اقتصادية في مختلف المجالات (الزراعة، الأسماك، العقار، الفندقة وبيوت الإيواء، وفي مجالات السياحة المختلفة، والصناعات الحرفية أوالتحويلية، النقل بصفة عامة وبأنواعها: البحري، البري، الجوي، التعدين والمنتجات النقطية... وفي كل مجال تراه الدولة مجدياً اقتصادياً).
هناك فرص استثمارية صغيرة على مستوى عامة الناس، ويمكن أن تكون محفظة إدخار جيدة للمواطن، وأيضاً هناك فرص عمل يمكن أن تستوعب عدداً أكبر من العمالة المحلية ألاوهي: محلات (الهيبرماركت) إذا ما تم تحويلها إلى جمعيات تجارية تعاونية مساهمة عامة، لأن هذه المحلات أصبحت كبيرة جداً في حجم السلع، ومنتشرة في معظم المحافظات، وتستوعب عدداً أكبر من العمالة، خلاف كونها ذات مردود اقتصادي جيد بما تحتويه من سلع استهلاكية لا غنى عنها.
لقد استولت تلك المحلات على العمل الذي كان في محلات بيع المواد الغذائية الصغيرة التي عمنت (خص ممارسة العمل بها للعمانيين).
تمتلك عمان مقومات اقتصادية قلما تملكها غيرها؛ فعمان لديها موقع جغرافي استراتيجي، (ملتقى القارات)، بين آسيا وأفريقيا، وأيضاً أوروبا عبر البحر الأحمر، وتضاريسها متنوعة تجمع بين السهل والجبل والصحراء، ومقصد أي سائح، وبها موارد طبيعية بكر لم يتم اكتشافها بعد، خلاف ذلك لدى عمان سمعة تجارية عريقة عبر العصور، وتاريخ سياسي عظيم، خاصة مع دول شرق إفريقيا التي بها أراضي خصبة يمكن لعمان أن تستثمر فيها، هذه المقومات مجتمعة إذا ما استغلت بشكل صحيح لا شك أنها ستعوض عمان عن الريع الذي يأتيها من بيع النفط الذي تتحكم دول الكبرى في أسعاره.
إذاما استثمرت عمان في الأراضي الزراعية في البلدان التي كانت ترتبط معها تاريخياً لأصبحت من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الزراعية. أنا مازلت أفكر؛ ما الحاجة التي دعت إلى توظيف ثلاثين ألف مواطن من أصل خمسين ألف في الشرطة والدفاع؟ والبلد - آمن ولله الحمد ـ ألم يكن من الأجدى لو دربوا هؤلاء مهنياً وألحقوا بالمصانع؟
عندما يخطط لمخرجات التعليم يجب أن لا يكون عن منأى عن احتياجات سوق العمل، ولا يترك الخيار للقطاع الخاص يستقبل أو لا يستقبل هذه المخرجات؛ بينما يترك المجال مفتوحاًلاستقدام العمالة الوافدة التي جلها تكتسب الخبرة ميدانياً في عمان؛ فقط لكونها رخيصة التكلفة وتحقق ربحاً سريعاً ومجدياً للقطاع الخاص.
ماذا تستفيد الدولة من هذه العمالة غير تلك الرسوم السنوية البسيطة؟ ألم نفكر في استهلاك هذه العمالة لشوارعنا وحدائقنا العامة ومرافقنا العامة؟ خلاف ما تتركه من مخلفات ورائها للنظافة العامة هذا إضافة إلى مزاحمة المواطن في معيشته، لماذا يتحمل المواطن الضرائب، متساوياً مع الوافد، والبلد بلده والأرض أرضه؟
ويبقى أن نقول المواطن المتعلم، القادر للعمل ويملك النشاط والصحة حتى لو خفض راتبه، قد يجد سبيلاً آخر، يترك العمل ويبحث له عن عمل أفضل في مكان آخر، أو ربما سيضيق على نفسه قليلاً، ويقتصد في مصروفاته، ولكن المتقاعد الذي تجاوز سن العمل ماذا سيعمل؟ يجب أن لا يمس معاشه، لأنه حقه الذي أكتسبه من شقاء عمره، من طيلة فترة عمله، أُدِخر له أو أَدخَره مسبقاً لنفسه،مقتطعاًمن راتبه، وبنى عليه آماله، يكفيه رفع الدعم المعيشي أسوة بإخوانه، لعل كل ما يملكه من معاشه أو نصفه يذهب لعلاج أمراضه المزمنة أو أمراض شيخوخته، أنه الوتر الحساس الذي لا يجب الضرب عليه، إذ أنه لن يغتفر، لذا يجب عدم المساس به.
-
عبد الله السناوي
- شارك

-
عبد الله السناوي
- شارك
-