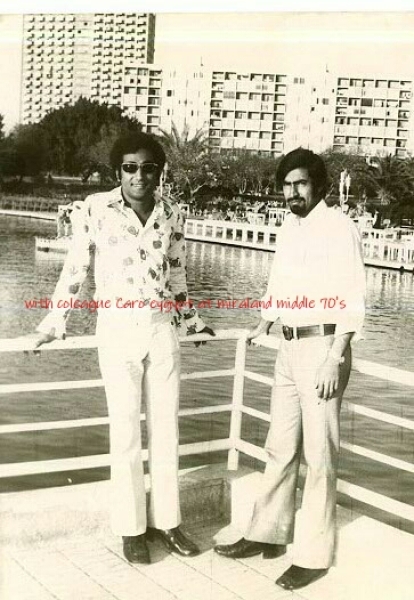-
-


مبنى دروازة مطرح القديم قبل ترميمه، في السبعينات عندما أنهار، ويظهر أمام الدروازة منصة شرطي المرور الذي يوجه السيارات قبل ادخال إشارات المرور في نهاية الثمينات في مسقط، ويظهر أيضا لافتة محطة بترول شل قبل استبدال مقرها بمركز للشرطة، بمطرح
حياتي الشخصية - الفقرة - السادسة - ٠٣٠ رحلتي إلى دبي
To read the article in other languages; Please click on the word “Language” at the top left of the page, highlighted in brown
ملاحظة: لقراءة هذا الموضوع تلقاءيا اطبع على "جوجل سيرش" السناوي الأسرة ثم عنوان أو رقم الموضوع
رحلتي إلى دبي - حياتي في دبي
استخراج جواز السفر عندما طلب مني والدي في عام ٦٨ أن أتقدم بطلب جواز سفر كنت في ذلك الوقت في إبراء بعد أن تركت بيت الفلج وأدركت في حينها بأن سفري إلى الخارج قد تحقق، وفي الحال استعرت دابة وركبتها إلى بلدة القابل(تعرف الآن بولاية القابل) وكان الدواب في ذلك الوقت هي الوسيلة الوحيدة التي تستخدم للتنقل بين المناطق، ولا أتذكر من كان برفقتي هل كنت بمفردي أم برفقة أحد أبناء قريتي لمقابلة شيخ القبيلة في الحصول على مأذونيه جواز السفر
المأذونية كانت تعرف باللهجة المحلية (بروة) وهي رسالة رسمية بشعار الدولة مضروبة على الآلة الكاتبة وهو نفس الشعار الحالي (السيف والخنجر) باللون الأخضر، لا أتذكر اللون تماماً، لكنها معنونه إلى جهة معينة في مسقط، تعطى من الشيخ يزكي حاملها الحصول على جواز السفر، ويجب أن يذهب بها بنفسه. وكان المكان الذي يقدم فيه الطلب في بيت مرتفع قريب من مسجد الخوض بمسقط، وأذكر عندما ذهبت إلى هناك وجدت أمة من الناس جالسين على الأرض، منتظرين مناداة أسمائهم في ساحة مقابلة لهذا المبنى. أتوا من مختلف مناطق عمان الكل يود السفر للعمل أو للعلاج خارج البلاد, كان الناس ينتظرون بجلد وتحت ظل الجدران للحصول على جواز سفر، العرق يتصبب منهم بسبب شدة الرطوبة وحرارة الجو، كانوا غير مبالين حتى لو انشوت أجسادهم في سبيل الحصول على ذلك الدفتر الأحمر الصغير الذي يخرجهم من البلاد
كان الانتظار يطول ويدوم طويلاً، وقد يطول أحياناً ليصل إلى أكثر من أسبوعين والناس تتردد بين مسقط ومطرح من محل إقامتهم، وكان المراجعون في كل صباح يركبون سيارات الأجرة من أمام دروازة مطرح المكان الذي به مركز شرطة مطرح حالياً، وفيما أظن أيضاً كانت هناك محطة لتعبئة وقود السيارات "شل" وأيضاً كان هناك مربط للحمير ومناخ للجمال التي تجلب الحطب وموقعه في الخلف عند مدخل الدروازة الذي يؤدي إلى حلة العرين (العريانة سابقا)
سيارات الأجرة تزدحم في الصباح، وتكاد تنعدم في بعض الأحيان بين مطرح ومسقط، وكانت معظمها من نوع لاندروفر قديمة، أو من نوع صالون فورد، أو لاند كروزر (تعرف بالعامية أبو شنب)، وفي مسقط تقع محطة سيارات الأجرة أمام دروازة مسقط جنوب المدرسة السعيدية، وأذكر مدخل الدروازة كان يؤدي إلى سوق شبيه بسوق سكة الظلام في مطرح. طبعاً تغير الحال الآن بعد التحديث الذي طرأ على منطقة قصر العلم، لكن ذكرى تلك الفترة بالنسبة لي جميلة ولا تنسى، كنت أتردد على هذه السوق كثيراً حتى بداية السبعينات، ما زالت روائح بضائع السوق عالقة في ذهني حتى الآن
في السابق كان من الصعب الحصول على جواز السفر، لا يعطى لأي مواطن حتى لو بلغ السن القانونية إلا بعد اجتياز عدد من الأسئلة الاختبارية التي تؤهله لذلك حتى لو كان مسنداً برسالة تزكية من شيخ القبيلة، ونادراً ما يحصل المراجع على مطلبه دون أن يعرق جبينه؛ فيضطر البعض اللجوء إلى الحيل والكذب لاختصار وتفادي الرد على الأسئلة خاصة تلك التي تتعلق بالسفر إلى بعض الدول العربية،...وأذكر عندما نودي باسمي أمسك يدي أحد الشياب من الذين كانوا بجانبي، وقال لي: (إذا سئلت عن سبب السفر قل لهم بأنك مرافق لأحد أقاربك للعلاج، ولا تذكر موضوع الدراسة أبدا)، فاستغربت من تلك النصيحة، وفعلاً عندما وصلت إلى ذلك المتعجرف قلت له كما قيل لي، وتمسكت برأيي، حيث علمت عنه مسبقاً بأنه جبار، إذا نادي على شخص و لم يستجب له بصوت عالٍ عند سماع الاسم فإنه يضع اسمه في أسفل القائمة أو يؤجل معاملته إلى اليوم الغد؛ ولكن عندما دخلت إلى ذلك الشخص المسئول، تغير كل شيء رأيت الهيبة والوقار، وأدركت بأنه من السادة، وصافحته باحترام بكلتا اليدين، ثم سألني بلطف عن سني وعن الجهة التي أرغب السفر إليها فأجبته بصدق، ثم سألني: للدراسة؟) فأجبته (نعم سيدي)، وبدأ يسدي لي النصائح والتوجيهات، منه "بعدم إساءة استخدام الجواز"، وأحسست بأنها نصيحة من أب حنون لولده، وخرجت من عنده وأنا مرتبك من الفرحة، وكدت أنسى إجراءات استلام جواز سفري وفي الحال أخذت مستند الاستلام وتوجهت إلى المبنى في الجهة المجاورة، وحصلت على الجواز في اليوم التالي، ولم تكن هذه المرة الأولى التي أقابل فيها أحد السادة، حيث سبق لي أن قابلت أحدهم في المرة الأولى عام ٦١ أو ٦٢ م عندما رافقت والدي إلى أفريقيا حيث قرر هو ومن معه قبل السفر بيومين الدخول للسلام عليه، وأذكر إني خضعت للتدريب ـ من قبل والدي لمدة ربع ساعة قبل الدخول ـ على كيفية البروتوكول (التحية والمصافحة وطريقة الجلوس) وقد أتقنت تلك التعليمات بجد ولم أخيب ظن والدي وكنت مؤدباً حتى أن سمو السيد أثني على أخلاقي
وبعد يومين من حصولي على جواز السفر، غادرت مطرح عن طريق البر برفقة أحد أصدقاء والدي الذي أوكل إليه مهمة سفري، وركبنا السيارة من مكتب النقل بحارة الشمال شمال دوار جبروه الحالي. و كانت البيانات تكتب في الجواز بخط اليد بالحبر السائل، ربما بواسطة خطاط؛ لهذا السبب كانت تتأخر. تحدد البلدان في الجواز من قبل السلطة عند إصداره أول مرة ثم تتم الإضافة فيما بعد، لا يوجد خيار، إذ كان لا يزيد عدد البلدان المصرح بها عن دولتين أو ثلاثة كحد أقصى من دول الخليج مع الهند.#
الرحلة إلى دبي
لا أتذكر تاريخ مغادرتنا مطرح إلى دبي ربما في سبتمبر من عام ٦٧ أو ٦٨ م، ولكني أتذكر بأن السيارة التي كانت تقلنا إلى دبي من نوع دوج (وانيت أمريكية الصنع)، هذا النوع من السيارات يعرف في وقتنا الحاضر بسيارات (بيك أب)، وكان مسلك الطريق عبر مناطق الباطنة الزراعية وأحياناً على الساحل بمحاذاة البحر، وفي تلال الرمال أحياناً أخرى، ثم عبر أودية ومرتفعات جبلية، وربما مناطق من وادي الجزي والله أعلم
كنا ملثمين لتجنب استنشاق الغبار حتى وصلنا منفذ الحدود بعد عناء وبعد مبيت ليلة واحدة في العراء. ولم تكن لدي قدرة على تحمل اهتزازات السيارة وارتجاجها سوى المقاومة والصبر بالصمت، هذه هي المرة الأولي التي أسافر فيها برفقة أحد من غير أقاربي
كان الصمت والسكون يخيم طوال الوقت على الركاب "لا اعتراض" الكل غريب عن الآخر، لا يوجد تجانس بيننا وكان مرافقي الذي أوكل إليه الإشراف على رحلتي يحدق فقط بعينيه من خلال لثامه، لازم الصمت مرافقي عدا بضع كلمات تصدر منه بين الحين والآخر تفيد بوقت الوقوف والأكل والشرب لا غير، ولم أجرؤ أن اسأله عن المكان الذي نقصده، ولا حتى عن ترتيب سكني ودراستي ومعيشتي هناك بصفة عامة، لكني اكتشفت وفيما بعد بأنه هو أيضاً لا يعرف شيئاً عدا أن قيل له عندما يصل دبي فقط عليه أن يسلمني لشخص معلوم هناك لا أكثر من ذلك ولا أقل
حياتي في دبي
وعند وصولنا دبي توقفت السيارة في ميدان بني يأس، و كان هذا الميدان عبارة عن ساحة رملية يعرف في السابق بميدان عبد الناصر على اسم الزعيم الراحل المصري، وبقي هذا الاسم متداولاً ربما حتى بداية الثمانينات. الميدان مزدحم بسيارات الأجرة "الوانيت" التي تنقل الركاب إلى مختلف مناطق دول الخليج، وما شد انتباهي في أول وهلة هو تواجد عدد كبير من الجاليات العربية على وجه الخصوص من الشام كعدد الأسيويين في وقتنا الحاضر، وبتشدد كانت تقوم بجمع تبرعات من الركاب لصالح المجهود الحربي الفلسطيني. رأيت رفيقي يناول جواز سفري من خلال فتحة صندقة لأحد الموظفين الشاميين، لست أدري، ربما لختم الإقامة هكذا ظننت، ثم مشينا إلى الفندق على الأقدام، في وسط السوق وليس بعيداً عن المكان الذي توقفت فيه السيارة ربما كان في نفس المنطقة التي بها محطة حافلات النقل العام حالياً على تقاطع الشارع المؤدي إلى مركز منال للتسوق
بالإضافة إلى الجاليات الشامية في دبي هناك جاليات أخرى من الصومال واليمن، وأيضاً من دول الخليج، وكذلك العمانيون القادمون من شرق أفريقيا، ولم الحظ عدداً كبيراً من الأسيويين كما هو الوضع في وقتنا الحاضر، ولكن بالنسبة لي فإنه أول مرة لي أرى فيه عرباً من دول كنا نسمع عنها عبر الإذاعات ونقرأ عنها في الصحف وكانت معظم الفنادق الصغيرة التي نمر عليها في الشارع تحمل لافتات بأسماء دول وأمكنة عربية كا: (فندق فلسطين وسوريا وشط العرب الخ..) وكانت تدار من قبل عرب
سكنت في أحد هذه الفنادق وقد تركني زميلي في غرفة كان يشاركني فيها أحد الشاميين، وقال:(بأن أحد سيأتي ليأخذني في المساء إلى المقر الذي سأسكن فيه) ولكني لم أجبه بشيء عدا "إن شاء الله"، وبالرغم من أني كنت خائفاً من ذلك الرجل الذي كان معي، إلا أنه وعلى كل حال قد سلمني جواز سفري تركني وذهب
وبعد قليل رأيت ذلك الشامي يخرج فشكرت ربي، لأنني لم أفهم ماذا يقول إذ أن العربية التي كان يتحدثها كانت غريبة بالنسبة لي، وهو أيضاً لم يكن يفهمني، وبعد فترة قليلة عاد ذلك الشامي من مشواره ومعه خبز تنور "خبز عجمي" وعدد من قرون الموز وأخذ يقطع الخبز ويأكل به الموز، وكنت اختلس النظر بين الحين والآخر لأرى ما ذا يفعل، ثم مد يده وبها قطعة خبز ملفوفة بالموز و يومئ برأسه يشير لي فيه أن آكل، بالرغم من أن الجوع كاد يقطع أمعائي إلا أنني رفضت أن اقبل منه شيئا فشكرته واعتذرت له، كنت لا أود أن أعطيه مجالاً للكلام، كل ما كنت أؤمله هو أن يأتي العصر ويجيء الرجل ليأخذني
بالرغم من صغر سني إذ كنت حينه بين العاشرة أو الثانية عشرة، إلا إنني كنت عاقلاً ذا بنية قوية، اكتسبتها من تلك الأعمال الشاقة التي اشتغلتها في إبراء عند غياب أبي عنا وتعودت على الوحدة، خاصة عندما كنت في أفريقيا من بداية الستينات حتى منتصفها، والإقامة في معسكر بيت الفلج والدراسة في مطرح، كل هذه الفترة أكسبتني مهارات التعامل مع الأشرار وأصقلت في الرجولة، أعرف كيف التعامل عند الخطر، أعددت على الصبر والتحمل، كنت كالصقر دائما متأهباً ومتلفتاً، كما كنت حادق النظر، ولا أثق في أحد
كما سبق أن ذكرت، لا أتذكر السبب، وكيف تم اختياري للسفر بالرغم من أن الناس من عمان كانت تتجه إلى العراق أو الكويت، لم تكن دبي مشهورة في التعليم في ذلك الوقت، وعندما ذكرت للرجل من جنوب الشرقية الذي كان يشاركني في انتظار الجوازات أخذ يهمهم:(دبي..دبي..!) تارة يتكئ على عصاه وتارة ينقش بها الأرض، ثم التفت إليّ وقال: (يا ولدي لماذا لا الكويت أو العراق؟) فأجبته بأني لا أعرف؛ هكذا المكان كما قال لي أبي
إقامتي في معسكر بيت الفلج
وأثناء إقامتي في معسكر بيت الفلج كان والدي قلقاً جداً بشأن تعليمنا أنا وأخي، ودائماً كانت الحيرة تتملكه، خاصة بعد أن انضم إلى أخي في وقت لاحق، وكنا نقطع كل صباح المسافة مشياً على الأقدام بين المعسكر والمدرسة بمطرح عند سور اللواتيا، ولم تكن الدراسة في هذه المدارس ترضي طموحات أبي، إذ كانت مدارس أهلية ذات المنهج الواحد وفقط يقتصر منهجها على تعليم اللغة الانجليزية، كذلك لم تكن بذات المستوى المعهود (سبورة وطباشير ومقاعد مدرسية ومناهج). كان الطالب الذي يلتحق بها أول ما يطلب منه من شيء هو أن يذهب إلى السوق ليشتري له كرسياً ليجلس عليه، هناك فرق شاسع بين هذه المدارس والمدارس بأفريقيا، على سبيل المثال المدرسة التي درست فيها في مدينة ممباسا بداية الستينات بدأ من عام ٦٢ م وذات معايير أوروبية ، والمدارس في مطرح في ذلك الوقت لا تتعدى كونها شيء من عدمه
كان أبي يغار علينا كلما رأى أبناء أصدقائه يدرسون ويبعثون من قبل أهلهم للتعليم خارج البلاد، ولكن ما ذا عساه أن يفعل وهو مكتوف اليدين ليس بيده حيلة لا يستطيع أن يترك عمله والاغتراب معنا، كما لا يستطيع أن يؤمن لنا المال الذي يكفل لنا الإقامة و التعليم بالخارج، خاصة أنه مقيد بانشغال باله لعدم وجود علاج لابنته المريضة في إبراء، كما أن ظروف عمله ليست ملكاً له، فهو جندي مقاتل ينقل من مكان لآخر حسب الأوامر العسكرية
لا توجد مدارس حديثة في البلاد عدا مدرسة ابتدائية واحدة محدودة العدد في الطلاب. بقي والدي معصوراً بين ضيقه المادي والمعيشة القاسية التي أرهقت كاهله، أنه خالي اليدين، الراتب الذي يتقاضاه من خدمته في الجندية بالكاد كان يؤمن له الأكل والشراب لأفراد الأسرة، ناهيك عن الديون المتراكمة من جراء رهن ضواحي أهله الذي لم يكن له ضلع فيه
شاءت الظروف أن يكون لوالدي أصدقاء أوفياء، ومن حسن الحظ كان هؤلاء الأصدقاء من الناس الميسورين نوعاً ما، ارتبط أبي معهم بعلاقة شخصية خاصة بحكم ثقافته واطلاعه على مجرى الأحداث والظروف السابقة المتمثلة في انعزالية البلاد عن العالم الخارجي، وكان هؤلاء الأصدقاء من التجار ممن لديهم السفن الشراعية التي يتاجرون بها بين دول الخليج، وكانت لهذه العلاقة أثر في إنقاذي من الجهل و لأنال نصيبي أنا أيضاً من التعليم الحديث أسوة بأبنائهم الذين سبقوني.إن لأصدقاء والدي هؤلاء، الفضل الكبير في التحاقي بمدارس دبي وتكفلهم رعايتي وإقامتي هناك
-
عبد الله السناوي
- شارك

-
عبد الله السناوي
- شارك
-